ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر
في التجربة الروائية:
حمزة الحسن
موقع الزميل حمزة الحسن الألكتروني
|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا |
|
|---|
|
بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق
|
|
مجموع زائري الموقع |
|
مواضيع متنوعة |
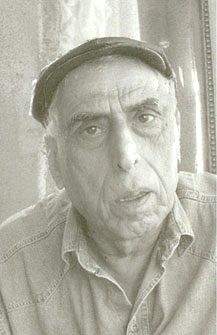
موقع الزميل حمزة الحسن الألكتروني
موقع إلكتروني يبث شريطا مصورا يظهر هجوما أمريكيا على مدنيين عراقيين
من مواقع أخرى
د. كاظم الموسوي
من أعمال الفنان مكي حسين
نزار رهك
ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر
في التجربة الروائية:
حمزة الحسن
موقع الزميل حمزة الحسن الألكتروني
مرفق الحل الذي أراه للوضع الاقتصادي والمالي العالمي
لقد تم نشر الكتاب بدعم من جامعة القدس
الكتاب مهم للباحثين بالدرجة الأولى
التحرر من اقتصادات القمار والخداع
مقطوعة فكرية في الاقتصاد السياسي
Liberation from the Economy of Gambling and Deception
A treatise on Political Economy
عبد الستار قاسم
هذا العمل عبارة عن مقطوعة فكرية وليس بحثا علميا، وهو اجتهاد الكاتب حول التحرر من الأزمة المالية العالمية والأزمات الاقتصادية التي تسببها الرأسمالية التحررية الحديثة.
الرأسمالية التحررية (الليبرالية) الحديثة هي عنوان مرحلة العولمة الأمريكية الهادفة إلى تشكيل النظامين السياسي والاقتصادي لدى مختلف الدول وفق الرؤية الأمريكية لما يجب أن تكون عليه الأمور. عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع دول غربية أخرى على ترسيخ النظام الرأسالي على المستوى العالمي إبان الحرب الباردة بالتي هي أحسن، لكن المقاربة اختلفت مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وأخذت أمريكا تعمل بهذا الاتجاه بالتي هي أحسن وبالتي هي أسوأ. أخذت أمريكا تستعمل قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية من أجل تشكيل الوضعين السياسي والاقتصادي خارجيا، ومن ثم تشكيل الوضعين التربوي والثقافي بحيث تصبح الشعوب أمريكية بالثقافة.
قالت أمريكا إنه قد ثبت أن نظامها السياسي الديمقراطي ونظامها الرأسمالي الحديث هما أفضل نظامين للإنسانية، وإن التطور الإنساني تاريخيا قد سار بهذا الاتجاه حتى استقر وتحققت نهاية التاريخ. لقد جربت الأمم أنظمة متعددة عبر الزمن، ولم يصمد منها إلا الأصلح. وذهبت أمريكا، على لسان عدد من مفكريها، إلى أبعد من ذلك بحيث قالت إنها هي التي تملك الحقيقة المطلقة التي ليس بعدها حقيقة، والتي يعبر عنها النظامان الاقتصادي والسياسي الأمريكيان، وإن كل الذين ينشدون الرخاء والطمأنينة لا بد أن يختاروا في النهاية هذه الحقيقة.
لم تنتظر أمريكا الأمم لكي تختار الحقيقة المطلقة، وأخذت تتبع سياسة إغرائية وإرهابية وإرعابية من أجل حث الدول على تبني النظام الديمقراطي وفق المقاييس الأمريكية، والرأسمالية الليبرالية الحديثة. نشرت أمريكا آلاف المنظمات غير الحكومية للترويج لأفكارها، وقدمت مساعدات لدول لكي تتبنى ما تطرح، وهددت دولا، وحاصرت أخرى، وشنت حروبا دموية، وتمخترت كثيرا مزهوة بعضلاتها العسكرية والمالية.
ربما ظنت أمريكا أنها ستعيد تجربة روما فيطول أمد حكمها، وتتربع على عرش العالم قرونا طويلة. لكن تجربتها لم تكن على مستوى ذكاء تجربة روما، وسرعان ما وجدت نفسها مصطدمة بإخفاقات جعلتها تتقلص في نظر العالم، وتقلص معها طرحها الفكري وجرأتها على المس بسيادة الدول. أصيبت الولايات المتحدة بإحباطات متتالية على المستويات العسكرية والأمنية والفكرية، وجاءت الأزمة المالية العالمية لتشكل ضربة قاسية جدا للطموحات الأمريكية وفكرة الرأسمالية التحررية (الليبرالية) الحديثة.
في هذه الورقة أناقش العلة الأساسية في فكرة الرأسمالية التحررية الحديثة، وصعوبة نجاحها في تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي للأمم، وبث الطمأنينة في نفوس الفقراء الذين يتطلعون دوما نحو تحقيق العدالة، أو الإنصاف على الأقل؛ ومن ثم أطرح مشروع حل للأزمة المالية التي يواجهها العالم، والتي أراها ذات جذور أخلاقية وسياسية.
هَوّس الأرباح
حمّل ماركس في نظريته الاقتصادية مسؤولية صراع الطبقات وما يرافقه من استغلال للطبقة العاملة واغتراب الإنسان للملكية الخاصة، والتي وصفها بأنها هي مصدر الشر وأصل السلوك الاستغلالي الذي عانى منه الإنسان على مر القرون. قال إن الملكية الخاصة تدفع صاحبها باستمرار نحو تنميتها ولو على حساب الآخرين، وكلما تراكمت تراكم معها الجشع واستغلال الإنسان. وقد تحداه كتاب ومنظرون اقتصاديون كثر، وقالوا إن الملكية الخاصة تشكل حافزا للنشاط والعمل، وإن المرء يبذل جهدا أكبر عندما يعمل لمصلحته الخاصة، في حين إنه يتراخى عندما يعمل في مصلحة عامة، أو لمصلحة عامة. قال نقاده إن الملكية الخاصة تشكل حافزا كبيرا للنشاط الإنساني، بينما تثبط الملكية العامة النشاط الإنساني، وتتسم بمعدل إنتاج متواضع أو هابط.
لدى ماركس نقطة قوية، ولدى خصومه نقطة قوية أيضا. ماركس قوي في حرصه على تحرير الإنسان من الاستغلال، وخصومه أقوياء من حيث توصيفهم للدافع الإنساني نحو العمل. وأرى أن العلة الحقيقية ليست في الملكية الخاصة بالتحديد، وإنما في الفكرة الربحية الكامنة فيها. وهي العلة التي أغفلها نقاد ماركس فأبقوا على الإنسان مستغِلا أو مستغَلا.
الهدف المبني في الملكية الخاصة في الرأسمالية هو تحقيق الأرباح، وإذا غابت الأرباح غاب الحافز للعمل، أو للاستمرار في الإنتاج أو تقديم الخدمات. وإذا كانت الرأسمالية المحلية (المقتصرة على دولة واحدة) تشهد نوعا من التنافس الذي من شأنه أن يحد من المغالاة في إدرار الأرباح، فإن الرأسمالية التحررية الحديثة تطلق العنان للشهوة الربحية وتتركها بدون كوابح. وهنا في اعتقادي الفكرة التي لم يعبر عنها ماركس بوضوح وهي أن هناك فرق شاسع بين الأكل من أجل العيش، والعيش من أجل الأكل. من الطبيعي أن يعمل الإنسان من أجل أن يأكل لأن الأكل حاجة طبيعية، وبين من يأكل حتى التخمة، أو حتى تكديس الطعام. من المفهوم أن يعمل الإنسان من أجل أن يكسب رزقا، وهذا أمر طبيعي، لكن العمل المستمر باتجاه تحقيق الأرباح فهو عملية مكتسبة. كسب الرزق والذي هو أرباح عبارة عن عملية طبيعية لأن البحث عن سبل الوفاء بالحاجات الطبيعية مثل الطعام يتطلب ذلك، لكن السعي نحو مراكمة الأرباح مكتسب.
الرأسمالية مبنية على مراكمة الأرباح وليس على كسب الرزق، ومراكمة الأرباح تشكل الهدف النهائي الذي يسعى إليه الرأسمالي. هنا أوضح أن السعي نحو تحقيق الأرباح ليس عيبا أو نقيصة، لكن السعي نحو مراكمة الأرباح قد ينطوي على أساليب ووسائل تؤذي الآخرين أو تسلبهم أموالهم. الرأسمالية ليست نظاما يحرص على الإنتاج بهدف توفير الاكتفاء الذاتي والتدرج في تحسين الظروف المعيشية للناس، والرقي بالحياة الاقتصادية للإنسان بوجهيها الاستهلاكي والاستثماري، وإنما نظام يحرص على تحقيق الأرباح ليحقق جباتها مستويات من الرفاه والسيطرة لا يصلها عامة الناس. والأرباح لا سقف لها ولا حدود، وكلما حقق الرأسمالي ربحا تطلع إلى ربح آخر؛ وما عليه إلا أن يبقى مستنفرا باحثا عن مختلف الوسائل والأساليب الممكنة لتحقيق مزيد من الأرباح. إنه جشع، ولا حدود لجشعه، وهو لا يعبر عن اكتفائه الربحي إلا إذا كان عاجزا عن تحقيق المزيد من الأرباح.
التطوير الاقتصادي بالنسبة للرأسمالية عبارة عن نتيجة وليس هدفا. إنه نتيجة لسعي الأفراد لتحقيق أكبر كمية من الأرباح، فهم يعملون ويجدون ويقيمون المعامل والمصانع والمزارع ويوفرون الخدمات بسبب قناعتهم بأن في ذلك ما يحقق الأرباح. وبما أن الهدف هو الأرباح فإن القيمةالإنسانية الناجمة عن النشاط الاقتصادي ثانوية ومترتبة وليست أصيلة. أي أن الإقبال على النشاط الاقتصادي ليس بهدف إنساني أو بهدف الرقي بالدولة أو الأمة ككل، أو بدافع إنساني وإنما بهدف خدمة المصلحة الخاصة، هذه النقطة من أهم أسس الرأسمالية. فلو لم تكن الأرباح هي الغاية لما كان السعي الحثيث نحو المشاريع التي تحقق أرباحا.
هذا ينسجم تماما مع مبدأ الفردية التي تنطلق منها الرأسمالية، والتي تقول إن سعي الفرد لتحقيق مصالحه يؤدي إلى تحقيق مصالح جماعية. أي أن الجماعية عبارة عن نتاج، وليست أحد مكونات الشخصية الإنسانية، وهي تتبلور على هامش السلوك الفردي.
ما يترتب على المصلحة الخاصة من قيم إنسانية يختلف كثيرا عن القيم الإنسانية التي تترتب على سلوك موجه نحو هدف عام. قد تؤدي الأنانية إلى التطوير الاقتصادي وتحسين الدخول، لكن القيم المترتبة على ذلك تختلف عن القيم التي تترتب على تحقيق تطوير اقتصادي كهدف أصيل وعام. ربما يتحقق التطوير الاقتصادي في الحالتين، لكن الترتيب الأخلاقي والاجتماعي الناجم عن كليهما ليس واحدا. إذا كان الهدف هو تحقيق الأرباح فإنه لا مانع من تجاهل قيم إنسانية أو التحايل عليها أو مخالفتها إذا كان ذلك في مصلحة ربحية.
مراكمة الأرباح قيمة عليا
مراكمة الأرباح هي القيمة العليا في الرأسمالية، فهي المقياس الذي تقاس وفقه أو حسبه مختلف القيم. القيم تبقى ذات شأن إذا ترتبت عليها أرباح، وهي لا قيمة لها وتلقى في المهملات إذا لم تترتب عليها أرباح، أو إذا كان التمسك بها يؤدي إلى انخفاض في الأرباح. الصدق فضيلة في الرأسمالية لأن الصفقات التجارية والمالية والوعود التجارية تتعطل بدونه، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية والتزويدية والنقلية، الخ. والزنا والعهر عبارة عن فضيلة أيضا لأن الاشتغال بالدعارة يدر أرباحا طائلة، أما العفاف فلا يحظى بقيم عليا بسبب آثاره السلبية على بعض النشاطات التجارية. الوفاء بالوعد عبارة عن فضيلة أيضا لأنه يوفر الوقت ويسهل العمل الاقتصادي والمالي، أما العناية الشخصية المباشرة بالأب والأم المسنين فليست من الفضائل لأنها تؤثر سلبا على الإنجازات الربحية.
لا نغفل بالطبع عن أن للإنسان حاجات ومتطلبات غير الأرباح، وربما هي التي تدفعه بالطبيعة نحو السعي والبحث عن الطعام والمأوى والكساء. هناك دافع طبيعي أو أحيائي (بيولوجي) نحو بعض النشاط الاقتصادي الذي يدر رزقا (ربحا)، لكن الحديث هنا هو حول تحقيق أرباح تضع الأفراد في حالة اقتصادية ومالية متميزة، إنه حديث يتخطى مسألة الاكتفاء والنمو الاقتصادي الذي يعم خيره على الجميع بصورة عامة. الإنسان يسعى لتحصيل لقمة الخبز ولتحسين ظروفه المعيشية، وجعل حياته أقل شقاء وأكثر بحبوحة ورخاء، لكن المنطق الإنساني يغيب عندما يتحول النشاط الاقتصادي إلى أرباح تتضمن استغلال الآخرين، وتحقيق حياة ترف تتغذى على راحة الآخرين ونصيبهم المادي.
ما الذي يدفع شركة رأسمالية ضخمة إلى بناء مصانع لها في الهند أو باكستان؟ الأرباح. الأيدي العاملة في الهند رخيصة مقارنة بالأجور في الولايات المتحدة، وتكاليف إنتاج ذات السلعة في الهند أقل بكثير منها في الولايات المتحدة؛ وما دامت الأرباح هي الغاية فإن الشركة لا يهمها طرد عمالها الأمريكيين في سبيل جني أرباح أكثر من خلال تشغيل عمال هنود. استغلال الإنسان الذي يقبل بالأجر القليل بسبب حاجته، وتعذيب الإنسان الذي يُطرد من عمله لا يعني شيئا بالنسبة للباحث عن الأرباح.
النشاط الاقتصادي في الرأسمالية التحررية الحديثة لا قيمة له ما لم يتمخض عن أرباح، حتى لو كان ضروريا لتلبية حاجة أو احتياج إنساني. وحسب ذات المنطق، إذا كان بالإمكان تحقيق أرباح بدون نشاط اقتصادي فلا مانع. قيمة النشاط الاقتصادي نابعة من الأرباح، والأرباح تعطي الأنشطة غير الاقتصادية قيمة عليا. إذا كانت زراعة القمح ضرورية من أجل أن تقف الدولة على أقدامها في مواجهة حصار اقتصادي خارجي فإن الرأسمالي لا يقدم على ذلك إذا كانت الأرباح المتوقعة أقل من المطلوب، أو إذا كان هناك فرص بديلة تدر أرباحا أكثر؛ وإذا كان الكذب وسيلة جيدة لتحقيق أرباح سريعة فإن الرأسمالي سيقدم على ذلك إذا اطمأن أن القانون لا يطاله.
بالنسبة للرأسمالي، الأرباح هي التي تحدد معنى كل من الخير والشر. ما يؤدي إلى جني الأرباح خير، وما لا يؤدي إلى أرباح، أو يؤدي إلى خسائر شر. الخير والشر بالنسبة له غير مرتبطين بمعايير إنسانية أو بأبعاد أخلاقية ذات بعد إنساني عام، وإنما ببعد مادي واضح وهو الأرباح. إنه يقدم على النشاطات التي تدر أرباحا، ويبتعد عن النشاطات التي تؤدي إلى لا-أرباح أو خسائر. إلهه هو الأرباح، ونبيه الأرباح، والدنيا من حوله تتم ترجمتها وفق معيار الربح والخسارة. وهذا لا يتناقض مع نشاطات الإحسان التي يقوم بها أثرياء لأن هذه النشاطات تساهم في تعزيز الأدوار الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية للمحسنين. ذلك دون أن ننكر احتمال الإحسان لوجه الله. أي أن التعميم عن الأرباح هنا ليس بالمطلق، وإنما ليس بعيدا عن المطلق.
قانون التنافس وقانون الاستغلال
أيقنت الدول الرأسمالية الغربية مدى جشاعة الرأسمالية إثر الكساد الاقتصادي عام 1929. انهار النظام الاقتصادي الذي كان قائما على استبعاد التدخل في آلية السوق، وقررت الحكومات التدخل من أجل ضبط الوضع من ناحية التدخل الحكومي ماليا ونقديا، ومن ناحية وضع قوانين للتنافس ومنع الاحتكار. نجحت هذه الدول إلى حد كبير في استعادة النشاط الاقتصادي، وأخذت الأوضاع الاقتصادية على المستويات المحلية في مختلف الدول الرأسمالية تتحسن.
استطاعت الرأسمالية أن تتجاوز المشاكل التي نجمت عن الكساد العظيم لعام 1929، واستطاعت أن تعالج الأسباب المحلية التي أدت إلى ذلك. وقد حققت الرأسمالية تقدما علميا جبارا، وحققت مستويات تقنية عالية ومتصاعدة، وأنجزت أيضا نموا اقتصاديا كبيرا انعكس على حياة الناس وظروفهم المعيشية. اتسعت الطبقة الوسطى في الدول الرأسمالية، وتقلص حجم الطبقة الفقيرة، وتحسن الوضع الاستهلاكي، وأصبحت الحياة المعيشية أكثر سهولة ويسرا بسبب ما قدمته التقنية من أدوات ووسائل بيتية خاصة بالطهي والتنظيف والإنارة والتدفئة، وأصبحت الحياة إجمالا أكثر راحة واسترخاء ورفاهية.
إنما علينا ألا نغفل السلبيات التي ترتبت على التقدم التقني من حيث أن آلات الحرب والدمار قد تطورت، وشهد العالم سباقا للتسلح وإنتاج أسلحة التدمير والدمار. لقد تم استغلال الاكتشافات العلمية في تطوير اختراعات الهيمنة على الشعوب، وبث الرعب والإرهاب في مختلف أنحاء العالم، وتصدرت الدول الرأسمالية قائمة الدول التي تسعى إلى تنمية قدراتها العسكرية، والتي تعمل على السيطرة على ثروات العالم وإرادات الدول.
شكل عنصر الحوافز الشخصية أحد أهم أسس انطلاق الرأسمالية نحو مزيد من النشاط والتقدم. يبدو من الناحية التاريخية على الأقل، أن الرأسمالية قد تجاوبت مع سلوك إنساني واضح يتمثل في حرص الإنسان على مصلحته الخاصة أكثر من حرصه على المصلحة العامة. واضح تاريخيا أن استعداد الإنسان ليكد ويتعب في مصلحته الخاصة أشد من استعداده ليكد ويتعب في مصلحة عامة. من المحتمل أن يكون هناك أناس لديهم التزام تجاه المصلحة العامة أشد من التزامهم تجاه المصلحة الخاصة، لكن هؤلاء لا يشكلون القاعدة العامة التي ميزت سيرة الإنسان وتاريخ الأمم. هناك من يقول إن حرص الإنسان على مصلحته الخاصة عبارة عن نزعة طبيعية فطرية، بينما حرصه على المصلحة العامة مرتبط بالعوامل التربوية؛ ولهذا نراه مجدا ومجتهدا في مصلحته الخاصة، ومتهاونا في المصلحة العامة. هذا قول لا نستطيع إثباته، لكننا نستطيع أن نستنتج من تجارب الأمم أن العوامل التربوية تلعب دورا هاما في الحرص على المصالح.
المهم أن الحوافز لعبت دورا كبيرا في التقدم العلمي والاقتصادي والتقني لدى الرأسمالية، وما زالت تلعب هذا الدور. وقد عززت الرأسمالية هذا العنصر بعناصر أخرى على رأسها القيم المقننة التي من شأنها حماية النظام التداولي الرأسمالي من الكثير (وليس من كل) من أساليب النصب والاحتيال والتزوير والتقليد، الخ. رأت الرأسمالية أن الاعتماد على الضمير الإنساني لا يكفي لنجاح النظام الرأسمالي فعملت على سن قوانين تفصيلية تمس مختلف نشاطات الحياة؛ وأقامت نظاما قضائيا راقيا يفضُل مختلف أنظمة القضاء التي سادت العالم في العصر الحديث.
تشير مختلف الإحصاءات على مدى أكثر من مائة عام إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت في ظل الرأسمالية مثل النهوض العلمي والتقدم الصحي، وتحسن المستوى الاستهلاكي للعالم، وتطور وسائل الاتصال والمواصلات. الجامعات تنتشر في كل أنحاء العالم، والمختبرات العالمية ومراكز الأبحاث تنتشر، وكذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. تحسن مستوى التغذية، وارتفع متوسط عمر الإنسان، وتطورت برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتطور القضاء، وتحسنت ظروف المرأة والطفل وحقوق الإنسان. لقد تم تحقيق إنجازات كثيرة في ظل الرأسمالية، وهذا يعبر عن تجارب مهمة جدا لا بد من الاستفادة منها، إنما دون أن نغفل عن أن كل هذه التطورات والتحسينات لم تكن نتاج مبدأ بقدر ما كانت نتاج القيم الربحية.
قانون التنافس هو أهم القوانين الرأسمالية على الإطلاق لأنه ينظم العلاقات الرأسمالية، ويمنع الاحتكارات إلى حد كبير، ويحافظ نسبيا بالتفاعل مع قوانين العرض والطلب على مصلحة المستهلك والرأسمالي الصغير. كان من أهم صفات الرأسمالية التهام الرأسمال الصغير أو الضعيف من قبل الرأسمال الكبير، لكن قوانين التنافس قد حدت إلى درجة ما من غلواء هذه القسوة. عملت الدول الرأسمالية على سن قوانين تشجع التنافس، وتراقب عملية التلاعب بالأسعار والتكاليف حتى لا تضيق السوق وتصبح ملكا لبعض الرأسماليين الكبار. أي أنها وفرت نوعا من الحماية للمنتجين، أو مقدمي الخدمات الصغار. باختصار، حدت الرأسمالية بعد الكساد العظيم من صلف وجشع الرأسمالية التي كانت تقوم على العمل الحر الذي يرفض كل تدخل حكومي.
لكن علينا أن ننتبه أن القوي، من الناحية التاريخية كما هي لدى الرأسمالية، هو الذي يضع القانون؛ وغالبا ما يعكس القانون مصلحة القوي. وقد اعتادت الإنسانية على أن القوي هو الذي يضع القانون وينفذه، وكلما تعارض القانون مع مصلحة القوي يجد القانون طريقا إلى التعطيل من خلال التعديل أو إعادة التفسير أو التجاهل أو الإلغاء. القوة الأكبر في الرأسمالية تقع بيد الرأسماليين الكبار الذين يملكون الثروات الهائلة، وتقع ثانيا بيد وسائل الإعلام والتي يملكها رأسماليون، ومن ثم بيد السياسيين الذين يأتون في الغالب من الطبقات أو الفئات الثرية المتنفذة.
يتحد في الدول الرأسمالية التي تصف نفسها بالديمقراطية الثالوث: الرأسماليون الكبار ووسائل الإعلام والسياسيون. الرأسماليون الكبار أصحاب نفوذ وسطوة بسبب ما يملكونه من أموال، وهم أصحاب الوكالات الإعلامية الكبيرة، ومحطات التلفاز الضخمة، والصحف الشهيرة، وهم أيضا الذن يملكون المال الذي يمكنهم من تغذية الحملات الانتخابية سواء على المستوى الرئاسي أو المستوى التشريعي، أو حتى على مستوى المجالس البلدية. المال له بريقه، والناس بصورة عامة يلهثون وراءه، والإعلام عبارة عن سيف مسلط ووسيلة هامة في صياغة آراء الناس وتوليد الأفكار لديهم. أما السياسيون فهم أدوات التشريع والتنفيذ: هم الذين يضعون القوانين والتشريعات، وهم الذين يديرون مختلف الأجهزة الإدراية والتنفيذية للدولة. إن لم يكن هؤلاء السياسيون من أصحاب المال، فإنهم يحصلون على تمويل دعاياتهم الانتخابية من أصحاب المال، إلا ما ندر. هذا الثالوث هو الذي يحكم، وهو الذي يقرر للناس في مختلف مجالات الحياة، إنما بدون ضجة وبدون مظاهر استبدادية.
حدت القوانين الرأسمالية من الاستغلال، ووضعت الأرباح إلى حد كبير ضمن معادلات محددة تتم مراقبتها من خلال الآليات الرسمية التي تم فرضها، ومن خلال آلية السوق القائمة على التنافس. ومن حيث أن الأرباح هي المحرك الأول للرأسمالي والغاية النهائية لمختلف نشاطاته الاقتصادية والمالية، كان من الضروري تطوير أفكار جديدة يؤدي تطبيقها إلى جمع أرباح إضافية. لم يعد الرأسمالي مكتفيا بالأرباح التي تتيحها السوق المقننة، وعمل على البحث عن ثغرات ينفذ من خلالها لإشباع نهمه وجشعه. كان ذلك من خلال آليات تقع على رأسها المضاربات أو القمار، والخداع.
الخداع
يقوم الخداع في العالم الرأسمالي على مبدأين أساسيين وهما: فتح الشهية للاستهلاك وإحداث خلل بين الخدمات والإنتاج وذلك بهدف رفع مستوى الإنفاق أو الشراء، والاستمرار في البحث عن مصادر تمويل تكاليف الخدمات. إن أهم ما يركز عليه الرأسمالي هو زيادة مبيعاته على مستويي السلع والخدمات باستمرار لما في ذلك من أرباح، وعينه دائما على المستهلك الذي تشكل نشاطاته الشرائية الضمانة الوحيدة لتحقيق الهدف.
يتفنن العالم الرأسمالي بفنون التسويق وبطرق فتح شهية المستهلكين، وطور فنا اسمه فن التسويق، وهدفه الأساسي هو ترويج البضائع والخدمات، أو تحقيق أكبر قدر من المبيعات. تطورت أساليب الدعاية والإعلان، وتطور فن التغليف والزخرفة، وتطورت أساليب إقناع المستهلكين بالشراء. بدأت الشركات توظف نسبا متصاعدة من ميزانياتها لصالح أعمال الدعاية والإعلان، وأخذت تتسابق على توظيف محترفي فنون التسويق والدعاية.
ظهرت النساء الجميلات اللامعات على شاشات التلفاز وهن يروجن للغسالة والبراد وفرن الغاز والشامبو والصابون ومكيف الهواء وأنواع الشوكولاته وأنواع معاجين الأسنان والعطور وطلاء الأظافر وتسريحات الشعر والملابس، وظهرت فضائيات متخصصة بالتسويق والترويج للبضائع. كرس الرأسماليون جهودهم نحو إغراء المستهلك، وعملوا على جرّه نحو السوق جرا، وطالبوه أن يبقى واقفا على رؤوس أصابع أقدامه متحفزا للشراء. وقد قدموا له الكثير من التسهيلات المالية لكي يبقى في السوق حاملا بيديه الجديد من المنتجات. ولهذا نجد شاشات التلفزة مزدحمة بالإعلانات التجارية، وكذلك الشبكة الإليكترونية والصحف المقروءة ووسائل الإعلام المسموعة، الخ. حيثما ذهبت في أي مكان في العالم، أنت تتعرض لقصف إعلاني متواصل ومحموم، وجميع المنتجين يطلبون منك شراء منتوجاتهم لأنها الأفضل والأنسب والأكثر ديمومة.
أصابت الرأسمالية الإنسان بهوس أو جنون الشراء، أو الاستهلاك، وصنعت عادة اللهاث وراء التقليعات وآخر طراز وآخر صرعة، وآخر إضافة. أنظر مثلا جنون الشباب والشابات فيما يتعلق بأجهزة الخلوي، وتتبعهم لآخر صيحات الخدمات التي يقدمها الجهاز والسعي إلى الشراء. من الناحية العملية، لا تقدم آخر الصيحات فائدة حقيقية متناسبة مع الثمن الذي يدفعه الشباب، لكنها صيحات جذابة يصعب على شاب أو شابة في مقتبل العمر مقاومتها. وحولت الشركات هذه الصيحات إلى مجال للمنافسة الانتقائية بين الشباب والشابات بحيث ينظر إلى صاحب الجهاز غير المتطور على أنه/ا متخلف/ة. ولك أن تحسب كم من الأموال تكلف هذه المسألة الآباء والأمهات، مضيفا إليها تكاليف المكالمات والرسائل المختلفة.
أو أنظر مثلا إلى سباق النساء على آخر صرعات الملابس المتنوعة من قمصان وفساتين وتنانير وسراويل، الخ. نسبة كبيرة من نساء الأرض يملكن معلومات جيدة عن آخر هذه الصيحات، وأغلبهن يعملن على شرائها، ويعتبرن ذلك نوعا من التقدم الإنساني والحضاري، ولو بحثت في البيوت لوجدتها مليئة بالملابس النسوية، وربما تستطيع بعض النساء أن تقيم محلا تجاريا بالملابس التي تملكها. ملابس جديدة وثمينة يتم إلقاؤها بالنفايات ليس لشيء إلا لأن صانع الصيحات في روما قد قرر أنها ملابس لا تصلح للاستعمال الإنساني الحضاري، وهي ملابس أصبحت قديمة لا ترتديها إلا النساء المتخلفات.
أو ربما هناك من يرغب في البحث عن اهتمامات الأثرياء بآخر صرعات السيارات المكشوفة والمغطاة والرياضية والسريعة، الخ، عملية استبدال السيارات تحصل بطريقة جنونية، وهي تكلف مبالغ باهظة، وتزهق نفوسا كثيرة بخاصة من الشباب المهووس بالتبجح والتلاعب.
كل هذا يكلف الكثير من المال الذي يذهب على حساب نشاطات حيوية وجوهرية مثل التعليم والصحة ودعم الفقراء والمحتاجين. أناس باتوا يفضلون التركيز على الاستهلاك على تسديد أقساط الجامعة لأبنائهم، أو يفضلون بقاء ابنتهم بدون زواج لأن العريس لا يملك ما يكفي من المال لتغطية تكاليف حفلة العرس، أو أكل القليل من الطعام الذي قد لا يكون مغذيا من أجل توفير المال لشراء الحلية ومواد الزينة. العالم ينفق المليارات على مواد التجميل، لكنه ينفق الملايين على مكافحة بعض الأمراض الخطيرة، وكمية الطعام الفاخر التي تلقى في النفايات تطعم مئات ملايين الجياع.
باختصار، الرأسمالية صنعت ثقافة استهلاكية مرعبة، وما زالت تمعن في ذلك، ولا يبدو أنها تملك كوابح للتهدئة، أو نية لإعادة تقييم الأمور. إنها تصنع الإغراءات وتفتح شهوات الناس للبحث عن المزيد من الاستهلاك، وواضح أن الناس في كل بقاع الأرض يتقبلون هذه الثقافة وينصاعون إراديا ولا إراديا لرغبات المنتجين. وكلما غرق الناس في الاستهلاك، خفت قدراتهم النقدية والتحليلية وتحولوا إلى مجرد أدوات يتحكم الغير بتحديد تصرفاتها وسلوكها. وهذه هي النتيجة التي يريدها الرأسمالي وهي عالم من الشهوانيين الذين يختلفون عن الحيوانات فقط في فنون الاستهلاك وليس في الاهتمامات.
التحليل والتفكير الحر عبارة عن عدوين كبيرين للسلطات المتنفذة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. أصحاب النفوذ الاقتصادي يرون في الثقافة العامة والتفكير الحر ورقي التحليل وسمو المستوى الأخلاقي خطرا عليهم. أصحاب العقل النقدي يعملون على توجيه الناس وتوعيتهم بالمخاطر التي تحيق بهم مما يثير الكثير من الانتقادات لسلوك الرأسماليين واهتماماتهم. المعاداة المباشرة لأصحاب الكلمة الحرة والقدرات النقدية والتحليلية لا تفيد، ويبقى من الأسلم تثقيف الناس تدريجيا لكي يتقبلوا واقعا جديدا يصبح جزءا من تركيبهم النفسي. وأكبر مثال على ذلك هو تحويل الدعارة إلى تجارة رائجة مسموح بها، ومقبولة من قبل جمهور الناس في العالم. كانت نيو يورك ترفض الدعارة، وكذلك باريس ولندن، لكن الآن بيوت الدعارة منتشرة في أغلب بقاع الأرض، وهي تجارة تأتي بمليارات الدولارات من الأرباح. كانت المجتمعات ترفض مثل هذه الأعمال، لكنها أصبحت الآن نوعا من أنواع الحرية على الرغم من الأضرار والأمراض الاجتماعية والصحية التي تنجم عنها. وقد تطورت الأمور مع الزمن حتى أصبحت الدعارة على شاشات الفضائيات وتدخل أغلب البيوت في العالم، وعلى الأقراص المدمجة، ومتوفرة في الأسواق. إنها حرية ربحية، لكن أين حرية المجتمع في أن يكون سليما ومعافى؟
ثغرة الخدمات
يعتبر التركيز على تقديم خدمات جديدة وتحسين خدمات قائمة من أبرز اهتمامات الرأسماليين الآن وذلك بسبب ما تدره من أرباح كبيرة.. هناك خدمات الهاتف والمياه والكهرباء، وهي خدمات نستطيع القول إنها تقليدية وموجودة في أغلب بقاع الأرض، وهناك خدمات تنشأ مع تعقيد الحياة وارتفاع مستوى النشاطات الإنسانية المختلفة. فمثلا هناك الآن خدمات الشبكة الإليكترونية، وخدمات النفايات وتنظيف البيوت، وخدمات التسوق والمصارف المالية، الخ.
تغرق المجتمعات الآن بخاصة في الدول المتطورة اقتصاديا في الكثير من الخدمات التي تتطلب الكثير من النفقات المالية، ويبدو أن المجتمعات الأقل تطورا تعمل على المشابهة وتحاول تقديم مختلف الخدمات التي تطرأ. وواضح أن الخدمات ذات جاذبية للغالبية الساحقة من الناس بسبب ما تقدمه من راحة جسمانية، وربما ذهنية للإنسان، ومن الصعب جدا مقاومة إغرائها. والمشكلة التي تجسدت هنا هي أن الطلب على الخدمات لم يعد متناسبا مع الدخل أو مع الإنتاج مما يؤدي إلى هموم مالية كبيرة.
من المعروف أن الإنسان يحاول التمدد في رخاء الحياة تبعا لدخله المالي أو المردود الاقتصادي لنشاطاته. كلما ارتفع الدخل، تحسنت ظروف المعيشة ذلك لأن المرء يستطيع شراء ملابس أفضل، أو الذهاب إلى مطعم لتناول وجبة، أو دفع أقساط منزل، الخ. وهذه هي المعادلة التي يحرص عليها الإنسان العادي الذي لا يريد أن يمدد جسمه بأكثر من طول فراشه، وهي ذاتها المعادلة التي يجب أن تتمسك بها الدول والحكومات. لكن ما يحصل الآن هو أن إغراء الخدمات يجتاح نفوس العديد من الناس الذين ينهمكون في استعمالها أو شرائها دون أن تكون لديهم القدرة المالية الكافية لتسديد التكاليف، فيغرقون بالديون والهموم.
تم ترك هذه المسألة للسوق وآليته، وبقيت الحكومة بعيدة عن المشهد، أو مشاركة فيه. نظرا لإقبال الناس على الخدمات، حصل عدم توازن بين الدخل والنفقات، فظهرت مشكلة المديونية التي يكتوي بنارها الجميع: الجشِع والطماع والبهلول والضعيف والدول والشعوب.
تمويل النفقات المتصاعدة
هجمة المنتجين على المستهلكين قوية وشرسة، وهي تتطلب من المستهلك قضاء الكثير من الوقت في الأسواق باحثا عن منتجات جديدة. هذا يتطلب كمية كبيرة من المال قد تكون فوق طاقة المستهلكين. فما العمل؟ وجد المنتجون ومن معهم من الرأسماليين كالتجار والممولين حلا في تقديم القروض السهلة وتوفير بطاقة الاعتماد والائتمان الماليين. فتحت المصارف أبوابها أمام القروض السهلة التي لا تتطلب ضمانات معقدة، وفتحت مؤسسات التمويل السبل لإصدار بطاقات الائتمان غير باهظة الثمن، وأصبحت عملية شراء بيوت وسيارات ومختلف أشكال المواد الاستهلاكية والخدمات سهلة جدا. كل ما تحتاجه لشراء ثلاجة مثلا أو جهاز تلفاز هو أن تبرز بطاقة للبائع فيدخلها في جهاز بسيط أمامه، وتحمل بضاعتك وتخرج.
أصبح بالإمكان أن يحصل شاب صغير السن على قرض ويشتري سيارة، لكن دون مقدرة على سداد الديون لأنه لا يعمل أو لأن دخله متدن؛ وأصبح بإمكان كل الذين لا يملكون مالا أن يملكوا الكثير من الأشياء التي حرموا منها عبر الزمن. بذلك اختفت الضوابط المالية، واستمر الأثرياء بمراكمة الديون على الفقراء والمعوزين ظنا منهم أنهم يحققون الأرباح الطائلة.
عمقت هذه السياسات المالية الهوة بين الدخل والاستهلاك، وأخذت النفقات الاستهلاكية تفوق الدخل بصورة متصاعدة مما سبب الكثير من المعاناة النفسية والمادية للناس. فضلا عن عدم التوازن الذي أخذ يلقي بثقله على اقتصادات العالم بخاصة في الدول الثرية.
القمار
هل تريد تحقيق ثراء سريع؟ ممكن أن يتأتى ذلك في ليلة واحدة على طاولة القمار. قد يأتيك الحظ في لاس فيغاس فتخرج من صالة القمار مليونيرا، وعندها تشتري ما تشاء، وتصبح حياتك أكثر رفاهية ومتعة؛ إنما شريطة ألا تعود إلى صالة القمار. لم يعد القمار مقتصرا على صالة القمار، وإنما امتد إلى صالات البورصات العالمية والمحلية التي أصبحت مراكز لنشاط مالي محموم ومضاربات مالية وتحت لافتات مقبولة شعبيا واجتماعيا.
في الأصل، الأسواق المالية مصممة لتداول الأسهم بناء على أسس اقتصادية بحتة مما يشجع عملية الاستثمار. من المفروض أنها أسواق يطرح الناس فيها والشركات أسهمهم للبيع، ويُقبل المشترون لتفحص الأثمان، ولتقييم الوضع الاقتصادي للشركات المعنية. المفترض أن أسهم الشركة تكسب ثمنا أعلى إذا أثبتت الشركة نجاحها الاقتصادي، وإذا ثبت أن عملها يبشر بمستقبل جيد وبمزيد من الأرباح الحقيقية المتواكبة مع عملية إنتاجية حقيقية.
هذا الأصل لم يعد موجودا إلى حد كبير، وأصبحت تتعرض الأسواق للتلاعب من قبل الكثير من الجهات منها الشركة نفسها وكبار المساهمين فيها. تحولت الأسواق المالية إلى مراكز لنهب الفقراء وأصحاب القوة المالية المتوسطة، وتربع على عروشها أصحاب رؤوس الأموال القوية، والأذكياء الذين يملكون القدرة على رفع أسعار الأسهم وخفضها من خلال ألاعيبهم في البيع والشراء.
من السهل جدا صناعة الأوهام لدى الناس حول أسهم شركة معينة وذلك بشراء أعداد كبيرة منها وبطريقة ترفع سعر السهم وهميا، فيقبل الناس على الشراء ظنا منهم أن أرباح الشركة هائلة وأنها قوية اقتصاديا وتبشرهم بربح وفير. يضع العديد من الناس أموالهم في مثل هذه الشركة، وبعد حين عليهم أن يتلقوا مفاجأة هبوط الأسهم، ويتم نقل بعضهم على عجل إلى غرف الإنعاش بسبب الخسائر الكبيرة. صحيح أن بعض الناس يحققون أرباحا من خلال هذه الأسواق المالية، ولكنها تبقى الطُعْم الذي يستدرج الغالبية إلى الهاوية. وماذا يضير الرأسمالي إذا قدم مئات ألوف الدولارات كطُعْم مقابل أن يحصد الملايين بعد فترة وجيزة؟
الأسواق المالية العالمية عبارة عن أوكار للخداع والتضليل وتجريد الناس من ثرواتهم، وهي المكان الذي يلتقي فيه الذكاء والجشع والطمع مع الغباء. الذكاء المدمر هو سمة الرأسماليين الكبار، أما الطمع فهو سمة الناس الذين يحلمون دوما بالثراء السريع، والغباء هو سمة من يظن الخير بمن لا يهدف إلا لتحقيق الأرباح.
القانون يحمي الفوضى
القوي هو الذي يضع القانون في الغالب، وواضع القانون يراعي مصالحه على الدوام مهما بلغ من حسن النية والأخلاق الحميدة. الرأسماليون هم الذين يصيغون قوانين الرأسمالية بطريقة تتناسب مع أهدافهم في تحقيق الأرباح. أنظر مثلا كيف تضع الرأسمالية قوانين ضد الكذب، ولا تضع ضد الزنا على الرغم من أن الكذب والزنا ليسا من الأخلاق وكلاهما يساهمان في هدم المجتمع. الكذب عبارة عن آفة كبيرة تعرقل عمل الرأسمالية، أما الزنا فعبارة عن تجارة تدر الأرباح، وهذا ما جعل الكذب قضية عامة، وجعل الزنا من الحريات الشخصية.
قد يمس القانون بعض كبار الرأسماليين أحيانا، لكنه عادة يترك المس بالفقراء والمساكين والأغبياء بدون غطاء. فمثلا لا توجد قوانين صارمة لضبط خداع المستهلكين من خلال أساليب التسويق، ولا يوجد ضبط علمي لمواصفات البضائع التي يتم ترويجها، ولا يوجد حرص قانوني على كيفية تقديم القروض وبطاقات الائتمان. ولهذا نرى الفوضى في الساحتين الاقتصادية والمالية على المستويات الشعبية، بينما نرى نعومة في الانسياب القانوني حول انتقال رؤوس الأموال وحركتها على الساحة العالمية.
أخطر ما في الأمر القانوني أن المعاملات المالية والاقتصادية تتم على الصعيد العالمي في الغالب بدون تنظيم قانوني، وبدون مرجعيات قضائية، وهذا معناه بالضبط تمكين القوى الاقتصادية والمالية الكبرى على حساب القوى الصغيرة، أو تمكين الدول المتطورة صناعيا على حساب الدول النامية، وتمكين الشركات الكبرى العالمية على حساب الشركات الإقليمية والمحلية. تضغط أمريكا ومعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وتحرير التجارة وفتح الأسواق دون أن تكون هناك ضوابط قانونية، أو قوانين تصون مصالح الضعفاء والدول الفقيرة، وتقيم نوعا من التوازن بين التبادل التجاري ذي الطبيعة الاستثمارية وذلك ذي الطبيعة الاستهلاكية. وقد ربطت أمريكا مساعداتها المتنوعة للعديد من الدول النامية بشروطها المالية والاقتصادية، ذلك من أجل أن تستأثر بالأسواق وتحول أكبر عدد من الدول إلى مجرد أفلاك لا تستطيع الدوران بدون المركز.
وإذا كان لأحد أن يعتبرالاتفاقيات الدولية كمرجعية قانونية، فإنه من الضروري أن يراجعها ليجد أن مختلف بنودها تصب في النهاية لصالح الأقوياء. فمثلا ترفض الترتيبات العالمية الآن سياسة الحماية الاقتصادية، وتطلب من جميع الدول فتح أسواقها. هذا يبدو عدلا لأنه يساوي بين كل الدول. هذه المساواة بحد ذاتها هي الظلم، لأن الضعيف لا يستطيع منافسة القوي، وبالتالي لا بد أن يتخلى عن الإنتاج غير المجدي (أي الإنتاج الذي يحقق خسائرا)، ويتحول إلى أجير ومستهلك. أي أن المعاهدات الدولية والاتفاقيات تخدم الفوضى بدل أن تخدم النظام، والتوزيع العادل للثروة، أو التوزيع العادل للنشاط الاقتصادي الإنتاجي.
الخلاصة
الحصاد دائما من جنس البذار، والجشع يقتل الناس أولا، وقد يقتل صاحبه ثانيا. الأزمة المالية العالمية هي نتاج تخطيط الرأسماليين القائم على هدف الأرباح والمتغاضي عن قيم إنسانية أخرى يؤدي غيابها إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. لقد حصل خلل كبير على الساحة الدولية من الناحية الدولية مما أدى إلى هذه الحالة الاقتصادية الصعبة والتي تشهد تراجعا في النمو وارتفاعا في نسب البطالة في أغلب الدول. هذه حالة تستدعي إعادة النظر في العديد من الأسس والمرتكزات الأخلاقية للعمل المالي والنشاط الاقتصادي، لكنني لا أرى أن العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة مؤهل للقيام بهذه المهمة أو راغب في القيام بها.
الحل
من الملاحظ أن الرأسمالية تتمتع بقدرة على التكيف، وتعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تعترضها. هذا منطقي جدا لأن الرأسماليين حريصون على مصالحهم الخاصة، وهم ليسوا على استعداد لترك الأوضاع الاقتصادية تتدهور إلى درجة الانهيار التام. ولهذا استجابوا لضغوط العمال ولمطالب النقابات العمالية عبر الزمن وبطريقة تدريجية. لم تكن استجابتهم فورية ووفق إرادة العمال، لكنهم اتبعوا آلية الحوار، وعملوا على تقليل ثمن استجابتهم للمطالب العمالية والنقابية بقدر الإمكان. وواضح أنهم استطاعوا تجنب اضطرابات عاصفة في الكثير من الدول، وحالوا دون قيام ثورات تقلب الطاولة على مصالحهم المالية والاقتصادية، واستطاع العمال في أغلب الدول الصناعية تحسين ظروفهم المعيشية.
لكن قدرة الرأسمالية على التكيف ومرونتها في الاستجابة للضغوط لم تمنع التقلبات الاقتصادية الحادة من الوقوع، ولم تحل دون تعريض العالم وعموم الناس بخاصة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من دفع ثمن باهظ نتيجة هذه التقلبات. لقد لحقت بالناس وبالعالم خسائر كبيرة بسبب الكساد الكبير لعام 1929، وكذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة لعام 2008. تضرر أصحاب الدخول المحدودة إلى درجة أن أعدادا كبيرة من الأمريكيين اضطروا أن يخرجوا من مساكنهم المرهونة ليعيشوا في خيام تحت ظروف معيشية صعبة للغاية. ومع كل تقلب اقتصادي حاد تطفق الدول الرأسمالية باحثة عن حل ينقذها من الانهيار التام.
على مدى عشرات السنين والبحث عن حل جارٍ في داخل الرأسمالية وليس خارجها. بعد الكساد الكبير، رأى علماء الاقتصاد أن المشكلة الأساسية تكمن في اقتصادات حرية العمل Laissez Faire economy، ولهذا نبهوا إلى ضرورة تدخل الحكومة المحدود لكي يشكل صمام أمان ضد الفوضى الاقتصادية التي تنجم عن حرية السوق. ولهذا اتخذت الحكومات الغربية وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة قرارات سمحت للحكومة بالتدخل في الشؤون الاقتصادية من الناحيتين المالية والنقدية. وقد أصبحت هذه الحكومات في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين أكبر جهة إنفاقية في الدولة، وذلك لكي تخلق فرص عمل لملايين العاطلين.
فسرت الدول الرأسمالية الكبرى الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على أنها خلل كبير في السيولة بسبب عجز الجمهور عن الوفاء بالتزاماتهم المالية للمؤسسات المالية، وكانت البداية في قطاع العقارات. تجاوزت التزامات جمهور الناس المالية قدرتهم على الوفاء بسبب عدم التناسب بين الدخل والالتزام والذي نجم عن تهور المؤسسات المالية في منح القروض دون ضمانات كافية لتأمين السداد. فكرت هذه المؤسسات كثيرا بالأرباح التي تجنيها لقاء التوسع في التسهيلات المالية فوجدت نفسها بلا مال. هنا تدخلت الحكومات بخاصة حكومة الولايات المتحدة لتقديم مئات بلايين الدولارات للمؤسسات المالية والاقتصادية لتمنع انهيارها. وهنا تتمثل مهزلة الحل وهي أن الذين سببوا الأزمة هم الذين حصلوا على الأموال لكي يبقوا واقفين على أقدامهم، وإلا حصلت كارثة أعظم. صحيح أن حكومة الولايات المتحدة تكفلت بسداد ديون بعض الناس للمؤسسات العقارية، لكنها لم تضع حلا نهائيا يجنب الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الرأسمالي المخاطر ويحول دون هزات اقتصادية مستقبلية خطيرة.
فشل الحل من الداخل
المشكلة أن البحث عن الحلول ما زال يدور ضمن الرأسمالية ذلك لأن القائمين على شؤون العامة يؤمنون بالرأسمالية كنظام اقتصادي أمثل، ويؤمنون بأن النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية السائدة في الدولة يجب أن تتوافق مع النظام الرأسمالي. أي أنهم يصرون على أهمية انعكاس القيم الرأسمالية على النظم الأخرى لتحقيق الانسجام العام والمحكوم برؤى الرأسماليين. واضح أن السياسيين يتبنون الفكر الرأسمالي، ويتساوقون مع المضامين الرأسمالية أكثر مما يتساوقون مع المضامين الإنسانية.
تعاني الرأسمالية من خلل تركيبي ينبثق إلى أزمات بين الحين والآخر، في حين أن المعالجات التي تتم عبارة عن معالجات عرضية لا تمس تركيب الرأسمالية. ولهذا تبقى المعالجات العرضية ذات تأثير محدود ومؤقت، ويبقى الخلل التركيبي قائما لينفجر بين الحين والآخر. أساس الخلل التركيبي هو مراكمة الأرباح والتي تشكل القاعدة الأساسية لمختلف الترتيبات النظرية والعملية للنشاط الاقتصادي الرأسمالي، أما العرضي فلا يمس فكرة الأرباح، وإنما يتناول فقط كيفية تجاوز الأزمات إجرائيا وليس مبدأيا.
الأساس الربحي يقيم منظومة من القيم الأخلاقية مرتبطة بالهدف، ووفقها يتم ترتيب العلاقات العامة في المجتمع. هذه منظومة لا ترتكز على أبعاد إنسانية توازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وإنما تترك المصلحة العامة كنتاج للمصلحة الخاصة. إنها تقول إن المصلحة العامة تتحقق إذا قام كل فرد بالسعي الحثيث لتحقيق مصلحته الخاصة لأنه بذلك تقام المصانع والمزارع وتتوفر فرص العمل للجميع مما يدفع بالنشاط الاقتصادي إلى الأمام. هنا يكمن الخلل حيث أن ترتيب العلاقات العامة بما فيها العلاقات الاقتصادية يقوم على مبدأ المصلحة الخاصة أولا، ومن ثم تكون المصلحة العامة على هامش هذه الترتيبات. هناك فارق كبير بين العلاقات التي تنبثق عن مبدأ الأرباح أو المصلحة الخاصة، وبين تلك التي تنبثق عن مبدأ المصلحة العامة، أو مبدأ التوازن بين المصلحتين الخاصة والعامة.
وعليه فإن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل مواجهة الأزمات التي تولدها الرأسمالية تبقى ذات مفعول عرضي لا يمس تركيبة النظام الاقتصادي وما ينبثق عنه من منظومة أخلاقية، ويبقى المفعول مؤقتا.
الملكية الخاصة والأرباح
الملكية الخاصة بحد ذاتها ليست المشكلة الحقيقية، وإنما هوس الأرباح هو المشكلة. الملكية الخاصة عبارة عن آلية بينما الأرباح عبارة عن هدف، وهي الهدف الوحيد للرأسمالي كما أسلفنا. من الناحية المبدأية، الملكية الخاصة مشروعة، وكذلك الأرباح لأن الأولى تشكل نوعا من الإشباع النفسي، والثانية عبارة عن حافز قوي لاستخدام آلية الملكية الخاصة. فإذا تركنا الناس يبحثون عن الملكية الخاصة بدون ضوابط، ويسعون وراء مراكمة الأرباح بدون كوابح فإن النتيجة هي الجشع الذي لا حدود له، والذي يمكن أن يدمر الاقتصاد والبنى الاجتماعية والثقافية والفكرية.
هنا يجب أن نميز بين الأرباح بصورة عامة، وبين الأرباح التي تتحقق عن طريق الإنتاج وتقديم خدمات حقيقية للناس. هناك أرباح تتحقق بسبب عمل مباشر وجهد حقيقي يقوم به الشخص من أجل كسب الرزق، وهي أرباح مشروعة ويجب تشجيعها لأنها أساس البناء الاقتصادي، وهناك أرباح تقوم فقط على أكتاف الناس دون أن يكون هناك جهد عملي حقيقي منتج، وهي أرباح غير مشروعة. فمثلا يحقق تجار أرباحا في عرض البحر من خلال التبادل التجاري لبضائع لم تصل إلى أي ميناء، وكل تاجر يحقق أرباحا تتراكم في النهاية على رؤوس المستهلكين. قد يشتري تاجر الكيلوغرام من السكر من كوبا بمبلغ عشرين سنتا، لكنه يبيعه في عرض البحر لتاجر آخر فيصبح سعر الكيلو 30 سنتا، ويشتريه ثالث في عرض البحر أيضا فيصبح سعره 40 سنتا. ما أن يصل الكيلو إلى يد المستهلك حتى يكون سعره قد وصل 75 سنتا. من هم هؤلاء الذين استفادوا من الكيلوغرام؟ ربما ليس الفلاح الكوبي الذي يكد ويشقى ليل نهار ليؤمن لقمة خبز لأطفاله، وبالتأكيد ليس المستهلك. المستفيدون في الغالب هم التجار الذين لم يقدموا خدمة حقيقية للناس، ولم يقوموا بأي عملية إنتاجية. هؤلاء يحققون أرباحا عبر الفاكس أو رسائل الخلويات والشبكات الإليكترونية وهم يسترخون في مكاتبهم الفاخرة المكيفة، ويتداولون التحويلات المالية عبر المصارف العالمية دون أن يرى أحدهم دولارا واحدا.
كان من الممكن أن يُشترى الكيلوغرام الواحد من السكر من الفلاح بمبلغ أفضل من 20 سنتا، قل 25 سنتا، فيتحسن وضع الفلاح الكوبي، وكان من الممكن أن يصل الكيلوغرام إلى المستهلك في أذربيجان بسعر 50 سنتا. هناك 25 سنتا تذهب إلى جيوب الجشعين الذين هم في الحقيقة عالة على الإنسانية، ويسببون الكثير من المشاكل الاقتصادية في النهاية مثل التضخم المالي، وزيادة أعداد الفقراء.
على ذات الشاكلة أسوق مثلا من فلسطين حيث يتعب الفلاح ويكد من أجل لقمة الخبز. يبيع الفلاح الفلسطيني أحيانا صندوق الفلفل الأخضر للتاجر بمبلغ دولار وربع فقط، وينتقل الصندوق من يد تاجر إلى آخر ليصل للمستهلك وسعر الكيلوغرام الواحد 0,75 دولار. إذا كان وزن البضاعة في الصندوق 10 كيلوغرامات، فإن الكمية تباع بمبلغ سبعة ونصف دولار. أي أن الذين لا ينتجون يربحون ستة وربع من الدولارات، في حين لا يغطي الفلاح تكاليف الإنتاج ويبقى مدينا لتاجر البذار وتاجر المبيدات، الخ.
أما وقد ظهرت البضاعة الصينية في العالم، فإننا نرى أن السلعة التي يشتريها التاجر من مصدر إنتاجها بدولار واحد تباع بمبلغ ثمانية دولارات. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أجرة شحن السلعة من الصين إلى نيجيريا مثلا والتي قد تبلغ سنتين فقط، وأجرة التحميل والتنزيل والتي قد تبلغ سنتين أيضا فإن أصحاب رؤوس الأموال الذين لا ينتجون يحققون ربحا مقداره ست دولارات وستة وتسعين سنتا. بالتأكيد هناك تاجر لا مفر سيربح، وهذا حقه لأنه يقدم خدمة تسهل على الناس الحصول على البضاعة، لكن المشكلة تبقى في سقف الأرباح غير المعقول في كثير من الأحيان، وكذلك في عدد الأيدي المتاجِرة التي تشتري السلعة قبل أن تصل إلى يد المستهلك.
خذ تجارة الأراضي مثلا والتي يكثر فيها السماسرة والمزايدون والمحتكرون. يشتري تاجر أراضي قطعة أرض صالحة للبناء بمبلغ عشرة آلاف دولار، وهو مبلغ أقل من ثمنها الحقيقي لأن البائع محتاج للمال؛ ويأتي بعد ذلك تاجر آخر ليشتري ذات القطعة بمبلغ أربعة عشر ألف دولار؛ ثم يأتي ثالث وهكذا. يكون كل تاجر قد حقق ربحا بآلاف الدولارات دون أن يكون أي منهم قد قدم جهدا، وتباع الأرض في النهاية لصاحب حاجة يريد أن يبني منزلا بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار. كان من الممكن أن يشتري الشخص الذي يريد بناء منزل الأرض مباشرة من مالكها الأصلي بمبلغ اثني عشر ألف دولار ويوفر على نفسه مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار ذهبت لجيوب من لا يعملون.
هذا ينطبق على الصناع الذين يستوردون المواد الخام من دول فقيرة بأسعار زهيدة، ثم يبيعون المواد المصنعة بأسعار تفوق بأضعاف تكاليف الإنتاج. وينطبق أيضا على أسواق المال التي تعتبر، كما ذكرنا سابقا، مركزا لسرقة الفقراء ومتوسطي الحال.
باختصار، يحتوي النظام الرأسمالي القائم حاليا على عدد من مواطن الخلل الخطيرة والتي تسبب أضرارا كبيرة لعموم الناس بخاصة الفقراء ومتوسطي الحال وهي:
أولا: التجارة العالمية القائمة حاليا ووفق معايير الرأسماليين عبارة عن احتكار للثروة، واعتداء صارخ على حقوق الفقراء أفرادا ودولا.
ثانيا: هناك خلل كبير بين ما ينتجه الفرد وبين الخدمات التي يحصل عليها، ولا يستطيع تغطية الفارق إلا من خلال المديونية.
ثالثا: التسهيلات الائتمانية عبارة عن آفة اجتماعية وإنسانية تثقل كاهل الناس بدل أن تعالج مشاكلهم.
رابعا: الأسواق المالية أشبه ما تكون بكازينو للقمار لا يوجد فيه رابحون سوى المدير.
خامسا: فلسفة التسويق القائمة حاليا تعتمد الإغراء على حساب التعقل في الإنفاق، وهي تسبب أذى كبيرا لأصحاب الدخول المحدودة.
سادسا: تراجعت القيم الإنسانية لصالح القيم الربحية، وباطراد يتحول الإنسان إلى بضاعة.
سابعا: رأس المال الكبير يشفط الرأسمال الصغير على المستوى العالمي، وستنتهي الثروة بأيدي قلة من حيتان المال في الدول الصناعية الكبرى بخاصة الولايات المتحدة، وستنتهي الدول الفقيرة إلى مجرد أدوات أو مجرد عبيد لدى السادة.
الحل في تحرير المستوى السياسي
بما أن الخلل في الرأسمالية تركيبي والحلول عرضية، فإن الاستمرار في البحث عن حلول من داخل الرأسمالية لن يجدي نفعا على المدى الطويل على الرغم من أنها قد تهدئ روع الناس الاقتصادي مؤقتا. جرب العالم الحلول من الداخل، ولم ينجح، وهو عالم دائم الخوف من الانهيارات المالية والاقتصادية، والذي يستمر في تجربة ما ثبت فشله إنما يصر على الفشل.
الحل المنشود يجب أن يكون من خارج الرأسمالية، لكن ليس من خارج الثالوث المتحكم بأوضاع الناس وهو الرأسمالية ووسائل الإعلام والحكومات. أما وقد تحولت وسائل الإعلام إلى شركات رأسمالية لها مصالحها المرتبطة مع الرأسماليين، فإن البحث عن حل ينحصر في الحكومات والتي هي الحلقة الأضعف في التحالف الثلاثي ذلك لأن الذي يشكلها يعتمد في دعايته الانتخابية إلى حد كبير على الرأسماليين وعلى وسائل الإعلام، وكذلك في استمراريته في الحكم.
الحكومات هي التي تحمل الأمانة لأنها هي المشرفة على شؤون الناس العامة، ووجودها يهدف إلى رعاية شؤون الناس وتحسين أحوالهم ورفع مستوياتهم في مختلف المجالات، وإذا كنا نبحث عن تجنيب الناس الهموم والآلام فإننا لا نبحث في الرأسمالية والتي هي نظام اقتصادي ربحي وإنما في النظام السياسي الذي تقع على عاتقه مهمة مواجهة المشاكل العامة. الرأسمالي يبحث عن حلول لمشاكله هو، وهو بالتالي ليس المسؤول عن تجنيب الناس تبعات أعماله التي تغطيها قوانين الرأسمالية المحمية سياسيا، وإنما السياسي هو المسؤول.
النظام السياسي هو المسؤول الأول والأخير عن راحة الناس وأمنهم وطمأنينتهم، وليس أي نظام آخر مثل النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي. قد تحصل أحيانا مشاكل وتنشأ هموم بسبب النظام الاجتماعي، لكن المسؤولية في البحث عن حل لا تقع على النظام الاجتماعي، وإنما على النظام السياسي الذي عليه أن ينظر فيما إذا كانت المشاكل ناتجة عن خلل عرضي أو تركيبي؛ وإذا كان تركيبيا فإن على النظام السياسي القيام بخطوات تتجه نحو إحداث تحولات اجتماعية تركيبية، لا أن تقتصر معالجاته على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى حاله السابق. وإذا كان النظام السياسي غير راغب في البحث عن تحولات تركيبية في النظام الاجتماعي فإن النظام السياسي نفسه له مصلحة واضحة في التركيب الاجتماعي القائم. أو ربما نقول إن النظام السياسي هو ابن النظام الاجتماعي، أو يستمد شرعيته من هذا النظام.
وإذا كان النظام التعليمي لا يفي بالغرض، ولا يرتقي بالأمة من الناحية العلمية، فهل تتم معالجة هذا الأمر بتوظيف مزيد من المعلمين، أو تغيير مدراء التربية والتعليم؟ أم تتم معالجة الخلل من خلال النظر في تركيب النظام التعليمي؟ الخلل بالتأكيد في النظام التركيبي الأمر الذي يعني أن النظام السياسي يتبع نظاما تعليميا لا يؤدي إلى الرقي العلمي، بل ربما يتعمد النظام السياسي إقامة نظام تعليمي لا ينهض بالوعي الإنساني ولا بمستوى التفكير العلمي لدى الناس. أي أن الخلل في النظام السياسي، أو، على الأقل، أن مسؤولية معالجة الخلل تقع على عاتق النظام السياسي والتي تقع في صلب سياسته التعليمية.
هنا تكمن العقدة في النظام السياسي الغربي الرأسمالي وهي أن النظام السياسي عبارة عن خادم للنظام الرأسمالي وحارس على بقائه وسلامته. النظام السياسي ليس طليقا في تقييم الأمور العامة وتقدير التغيير الواجب اتباعه من أجل المحافظة على مصالح عموم الناس، بل هو أسير النظام الرأسمالي، ويرى أن مصلحة الجمهور تنبثق من مصلحة الرأسمالية، أو أن الحرص على المصلحة الخاصة يؤدي إلى خدمة المصلحة العامة. ولهذا تدور عملية الانتخابات السياسية ضمن بعد اقتصادي واضح، وتؤدي نتائجها إلى ترسيخ النظام الاقتصادي القائم بغض النظر عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات.
أي أن النظام الديمقراطي الغربي هو ليس نظاما إبداعيا بعيدا عن متطلبات الرأسمالية، إنما هو نظام متزاوج مع الرأسمالية، إن لم يكن خادما لها، بحيث أن الرأسمالية لا تستطيع أن تنتعش إلا في ظله، ولا تستطيع أن تتعايش ضمن قواعدها وأسسها الحالية إلا معه. النظام الديمقراطي الغربي القائم حاليا يتناسب مع متطلبات الرأسمالية، ويقيم نظاما من الحريات يخدم المبادئ الرأسمالية دون مبادئ التماسك الاجتماعي والرقي الأخلاقي، وقد أشرت إلى هذا سابقا من حيث أن القيمة العليا لنظام الحريات هي الأرباح.
فإذا كنا نبحث عن إصلاح اقتصادي يجنب عموم الناس الويلات فإن العلة في النظام التركيبي للرأسمالية والتي لا يقوى على معالجتها إلا النظام السياسي الحر غير المقيد بأسس الرأسمالية القائمة حاليا. وإذا كان هدف الرأسمالية هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح فإن هدف النظام السياسي الحر يجب أن يكون تحقيق أكبر قدر من العدالة. ولهذا من مهمات النظام السياسي هو تحقيق أكبر قدر من الحرية للناس مع تحقيق أكبر قدر من العدالة، وهذا ما يختلف مع فلسفة الحرية في الرأسمالية التي تدور حول العملية الاقتصادية المؤدية إلى الربحية. المفروض أن ما هو جيد للناس، جيد للنظام الاقتصادي، وليس ما هو جيد للنظام الاقتصادي جيد للناس.
الحرية والعدالة لا تتناقضان وإنما تنسجمان، وإذا كنا نظن أننا نقيم نظاما راقيا من الحريات ولم تتحقق العدالة (ليس المساواة) فإن ظننا خاطئ ويجب تصويب ما نقوم به. لا عدالة بدون حرية، ولا حرية بدون عدالة: إقامة العدالة تتطلب إقامة الحرية، والعكس صحيح؛ أو بمعنى أدق: الحرية لا يمكن إلا أن تفضي إلا إلى عدالة، والعدالة لا يمكن إلا أن تفضي إلى حرية. ومن المهم أن نبحث جميعا عن تلك الأوضاع التي تتحقق فيها الحرية والعدالة معا. هذا ممكن فقط إذا تم تحرير النظام السياسي من قهر الرأسمالية أو سيطرتها وبدأ يعي أن الأمانة تقتضي البحث في تركيبة الرأسمالية حتى لا تبقى تتغذى على حقوق الآخرين. النظام السياسي الجيد هو الذي يسأل دائما عما هو جيد للأمة أو للشعب، وليس عما هو جيد للرأسمالية أو لفئة معينة من الناس. إذا تحققت حرية النظام السياسي فإن المرونة السياسية في التعديل والتغيير والتطوير تصبح متوفرة، وتصبح هناك قدرة لدى النظام السياسي للسير في عملية إبداع متصاعدة.
هناك طغيان الآن من قبل وسائل الإعلام والبرامج الثقافية والفكرية والتربوية من ناحية تصوير النظام السياسي القائم على أنه النظام الإنساني النهائي الذي استقر عليه التاريخ. يقولون إن هذا النظام السياسي هو النظام النهائي الذي اهتدى إليه الإنسان بعد تجارب تاريخية مريرة، وإنه هو الذي يوفر العدالة والراحة والطمأنينة للناس جميعا. ولهذا تنشط الدول الديمقراطية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الترويج للديمقراطية على أنها النظام السياسي الأفضل، وتقيم من أجل ذلك مئات المراكز في العالم لتدريس الناس الديمقراطية وتعليمهم أسسها ومبادئها وطرق ممارستها، وتستقطب في سبيل ذلك عشرات الآلاف من المثقفين ليتولوا هم تدريس أبناء أوطانهم هذه الديمقراطية.
في هذا التدريس، هناك عملية خلط متعمدة بين الحرية والنظام الديمقراطي بحيث يتم تكريس الانطباع بأن الحرية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل النظام الديمقراطي. طبعا هذا عبارة عن تزوير لأن الحرية أوسع بكثير في مجالها ومداها من الديمقراطية، والحرية في الديمقراطية محصورة ضمن جدران الأسس الرأسمالية، بينما في الأصل يجب أن تكون طليقة بحيث يعبر الإنسان عن مختلف طاقاته الإنسانية حتى منتهاها وضمن عملية توازن دقيقة بين مختلف الطاقات يقررها هو. لا ننكر بأن الديمقراطية تعطي حريات، لكنها لا تستنفذها ولا تحيط بها. وهنا نذكر استبدادية رأس المال، واستبدادية وسائل الإعلام التي لم تعد سلطة رابعة بقدر ما أصبحت جزءا من أنظمة آيديولوجية تخدم أصحابها، واستحواذ المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال أموال الدعاية الانتخابية.
الأساس في تحرير النظام السياسي وإخراجه من الثالوث يكمن في تغيير أسس عمليتي الترشيح للانتخابات والدعاية الانتخابية. إذا تم تحرير المرشحين من سطوة أموال الرأسمالية، وتغيير أنماط وأساليب الدعاية الانتخابية بطريقة لا يتدخل فيها رأس المال، فإن الفائزين في الانتخابات لن يكونوا بحاجة لرضا الرأسماليين، ولن يوظفوا مكاتبهم العامة لخدمة أهداف خاصة، وسيكون بإمكانهم تقدير النشاط الاقتصادي الملائم لمصلحة الناس في ظل ظروف من الحرية مختلفة عن الظروف القائمة حاليا.
تقيم الديمقراطية القائمة حاليا عدالة عددية (مساواة) بين الناس فيما يتعلق بالترشيح والانتخاب، بمعنى أنها تفتح المجال أمام من يريد الترشح للانتخابات أن يترشح، وتفتح المجال للمنافسة المحتدمة بين المرشحين، وتتعامل مع الناس على أن أصواتهم جميعا متساوية. (على الرغم أنني مع وضع ضوابط مهنية للترشيح، وليس ضوابط عقائدية أو آيديولوجية أو سياسية. من الحرية أن تفتح باب تكافؤ الفرص، ومن حرية الناس أن يتقدم لقيادتهم من استطاع تحقيق سمو مهني مثل القدرة الكبيرة على الإدارة، أو تحقيق إنجازات علمية واجتماعية كبيرة للمجتمع وغير ذلك، يؤهله للقيام بالعمل العام. لكل مجتمع أن يضع ضوابطه المهنية وفق ظروفه هو دون أن تكون لهذه الضوابط أية أبعاد أخرى غير مهنية) لتكن هذه المساواة العددية على الرغم من أنها تتجاوز العدالة التوزيعية (الديناميكية) حتى لا يقيم أحد الحجة على النظام. لكن المهم هو أساليب وأنماط الدعاية الانتخابية إذ يجب إعادة النظر فيها جميعا حتى تتحقق أيضا العدالة العددية. من الملاحظ أن العدالة العددية يتم تطبيقها في أمور معينة، لكنها لا تُطبق عند الدعاية الانتخابية، ويتم ترك كل مرشح وفق قدراته الذاتية وما يمكن أن يجمعه من دعم وتأييد. هذا ناهيك عن تحيز وسائل الإعلام لصالح هذا المرشح أو ذاك.
ترك الباب مفتوحا أمام الدعاية الانتخابية ينحاز حقيقة لمن يملك على حساب من لا يملك، وينحاز لمن مع النظام على حساب من ينشد التغيير، ويترك المجال مفتوحا أمام المرشح وأعوانه ليضللوا الناس ويوهموهم بقدرات المرشح وإمكاناته العقلية والعلمية، الخ. الدعاية الانتخابية في ثوبها الحالي تفتح المجال للكذب والتضليل والاستحواذ على الناس، ولهذا يجب تغييرها. الدعاية الانتخابية في الدول الديمقراطية منحازة تماما لصالح المتنفذين اقتصاديا، وأحيانا لأصحاب النفوذ الاجتماعي بخاصة في الدول الديمقرطية التي ما زالت تحت وطأة نظام اجتماعي قديم. وإذا نظرنا إلى أعضاء المجالس التشريعية في الدول الديمقراطية فإننا نجد أن أغلبهم ممن يملكون القدرة المالية على الإنفاق الدعائي، أو يتلقون دعما ممن يملكون المال.
يجب أن تكون الدعاية الانتخابية من صلاحية مجلس عام متفق عليه ومنصوص عليه قانونيا، ويقوم على ترتيبها وتنظيمها ومراقبتها. هذا مجلس أشبه ما يكون بمجلس قضائي أعلى لكنه يختص فقط في الدعاية الانتخابية. إنه مجلس يحدد تماما النشاطات التي يمكن أن يقوم بها كل مرشح، والمحاضرات والندوات التي يمكن أن يقدمها، ويحدد كيفية النشر في الجرائد والظهور على شاشات التلفاز، الخ. وهو مجلس يساوي بين المرشحين جميعا ولا يترك الدعاية الانتخابية مزاجية، ووفق الإمكانات المادية.
مجلس تنظيم الدعاية الانتخابية هو الذي ينفق على الدعاية الانتخابية. لا توجد دعاية على نفقة المرشح نفسه، وإنما يجب تغطية النفقات من قبل الدولة، وهي نفقات غير مستردة ذلك لكي يتقدم للانتخابات كل من وجد في نفسه القدرة على القيادة. والأهم من ذلك أن المجلس هذا يحتفظ بالسيرة الذاتية لكل مرشح، وبتفاصيل موثقة حول أعماله وأخلاقه ومعاملاته وإنجازاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وخدماته لمجتمعه ووطنه وشعبه، وهو الذي يقوم بإطلاع الناس على شخص المرشح وعلى برنامجه الانتخابي المكتوب. لا يقوم المرشح بالتعريف بنفسه، وإنما تبقى مسألة التعريف متروكة للمجلس. هذه وسيلة مهمة في تجنيب الناس عملية التضليل، وهي أيضا مهمة في ردع غير القادرين عن الترشح للانتخابات.
ولأن هناك فروقا في الشخصية بين المرشحين، وفي القدرات وطريقة مخاطبة الناس، فإن الجمهور يطلع على هذه الفروق من خلال مناظرات ومناقشات وندوات ومحاضرات يقيمها المجلس وتتيح للجمهور فرصة التمييز بين مرشح وآخر فضلا عن المعلومات الدقيقة التي يوفرها المجلس عن كل مرشح.
هذا ترتيب يفتح المجال أمام من يجد في نفسه القدرة على قيادة الدولة أو لكي يكون عضوا في المجلس التشريعي أو أي مجلس تمثيلي آخر أن يترشح، وهو يحرر المرشحين من الضائقة المالية التي قد تحرمهم من الترشح، ومن سطوة المتبرعين الذين يبحثون دائما عن مكافآت فيما إذا فاز المرشح. هناك فقراء عباقرة لا يترشحون، وهناك أثرياء أغبياء يفوزون بالانتخابات بفضل أموالهم. كما أن هذا الترتيب يساوي بين المرشحين في الدعاية الانتخابية، ويردع من ليس لديه القدرة، ويحرر المرشحين من سطوة الأحزاب التي تشهد غالبا تكتلات متنافسة من أجل إفراز مرشحين. الأحزاب في هذا الترتيب تستطيع تأييد برنامج مرشح معين، لكنها لا تقوم بعمل الدعاية الانتخابية، ولا تلزم مرشحا ببرنامج انتخابي. وفي هذا ما يحرر المجتمع من استبدادية الأحزاب والتي أخذت بالتطور مع الزمن.
في هذا الترتيب، نحن ننتقل من استاتيكية (عددية) الطرح الانتخابي والفكري السياسي الذي هو الآن حكر على الأحزاب، إلى حيوية (ديناميكية) الأفكار. ننتقل من المحدودية إلى التعددية التفاعلية التي تشجع على الاجتهاد، ننتقل من الجمود الفكري ضمن حدود الرأسمالية، إلى الحيوية الفكرية التي تفتح آفاقا نحو إعادة ترتيب مختلف الأوضاع للدولة بطريقة تتعلم من التجرية والخطأ، وتعمل على مواجهة الأخطار، وتصويب المسار. هذا بحد ذاته يفتح المجال أمام تصويب الرأسمالية تركيبيا وليس عرضيا.
أوضح بالنسبة لاستبدادية الأحزاب أن أغلب الناس في أغلب دول العالم غير متحزبين، لكنهم مقيدون بانتخابات تجبرهم على اختيار أحزاب، واختيار أشخاص قد لا يثقون بهم لأن أسماءهم ترد في القائمة الانتخابية للحزب. عملت الأحزاب عبر الزمن على إلغاء الأشخاص لصالح الحزب، وأصبح الشخص غير قادر على خوض الانتخابات بارتياح إلا إذا كان عضوا في حزب. هذا غير منصف وغير عادل، وهو يؤدي إلى انتخاب أشخاص على غير كفاءة بسبب حزبيتهم، ويستبعد أشخاصا يمتلكون المعرفة والكفاءة بسبب عدم حزبيتهم. هذا يدعونا إلى إعادة النظر بطرق التمثيل والترشيح وتشكيل القوائم الحزبية، وإذا كان لدينا قناعة بالتعددية فإن استبعاد الأشخاص عن المسرح يتناقض تماما مع مبدأ التعددية.
مثل هذا الترتيب يحرر النظام السياسي من استبدادية رأس المال، واستبدادية وسائل الإعلام، واستبدادية الأحزاب، واستبدادية الثقافة التي صنعتها الرأسمالية، ومن الممكن أن يسير بالناس تدريجيا نحو هامش أوسع من الحريات، ونحو أمن اقتصادي أفضل لأن العدالة ستكون الهدف وليس التراكم الرأسمالي. إنه يحرر النظام السياسي من استعباد رأس المال، ويفك التحالف الشيطاني بين رأس المال ورجال الحكم.
معضلة الحرية
تعتبر حرية الاختيار من أهم أركان الديمقراطية، وهي الميزة الأساسية التي يعمل المتبنون للديمقراطية على إبرازها في دفاعهم عن النظام، وفي الترويج لها كأفضل نظام سياسي شهده التاريخ. هناك صحة في دفاعهم، ولا شك أن الديمقراطية تدافع عن حرية الاختيار، وحرية التعبير والتنقل، الخ. لكن المشكلة أن الديمقراطية ارتبطت بالرأسمالية، وأخذت تبعا لذلك تصبغ الحرية بالتعريف الرأسمالي للحرية والذي يركز على الفردية وحرية العمل وانتقال رأس المال، واعتبار المصلحة العامة كنتاج للمصلحة الخاصة.
لسنا بصدد البحث في الحرية باستفاضة هنا، إنما لا بد من التمييز بين الحرية والتحررية والذي تكاد الفلسفة الغربية تخلو منه. الحرية، وفق تعريف كاتب هذه الرسالة عبارة عن ممارسة الطاقات الإنسانية حتى منتهاها وبتوازن بينها يقرره الإنسان الحر؛ أما التحررية فهي التخلص من القيود الخارجية والتأثير غير المرغوب للقوى الخارجة على الذات. الطاقات الإنسانية تشمل الطاقات الجسمانية والمعنوية والعقلية مثل الطاقات الذهنية والعضلية والعاطفية والغضبية والانفعالية والأحيائية. الجوعان ليس بحر لأن طاقته العضوية الأحيائية لا تعبر عن نفسها بشكل سليم، وكذلك النّهم الذي لا يرحم أمعاءه؛ والممنوع من الكلام ليس بحر لأنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وكذلك الكسول الذي لا يمارس حركات جسمانية تعطي الصحة لجسده، ولا الذي يعيش في مجتمع يعتبر التعبير العاطفي عما يدور في النفس من خلجات أمرا معيبا.
أما التحرر فهو التخلص من المعوقات والمؤثرات خارج الذات الإنسانية والتي تحول بين الإنسان وقدرته على التعبير عن طاقاته. فنقول مثلا التحرر من الاستعمار ومن الاستعباد، والتحرر من الفقر ومن الظلم. التحرر شرط ضروري لممارسة الحرية، لكنه أيضا لا يفضي إلى الحرية إن لم يتوفر الوعي الإنساني بالذات والطاقات الإنسانية الكامنة. فحتى تتحقق حرية الإنسان، أمام الإنسان أن يعي ذاته، ويعي تماما الأوضاع الصحية التي يستطيع معها التعبير عن طاقاته حتى المنتهى الذي يحقق له التوازن، وأن يتحرر أيضا من مختلف القوى الخارجية التي تحول بينه وبين ممارسة حريته.
معضلة الحرية في التعريف الرأسمالي أن تعريفها مرتبط بعوامل خارج الذات، وهي عوامل مادية مرتبطة بالأرباح، أو بالمصلحة الشخصية، وليس مرتبطا بالتكامل الذاتي الذي يوحد بين الذاتي والموضوعي، أو يطور وعيا بكيفية تحقيق الانسجام بين الذاتي والموضوعي: أي بين القوى الخارجية الموضوعية، وبين انبثاق الطاقات الإنسانية، بين البعد الشخصي والبعد العام، بين الفردي والجماعي. إنها تربط الذاتي بإنجازات مادية، وتترك الموضوعي ليتحقق من خلال الذاتي ليكون العالم الخارجي مجرد أداة بدل أن يكون موضوعا للتفاعل. ولهذا فإن حرية الرأسمالية منتقصة من ناحيتين: ناحية التحقيق الذاتي من خلال التعبير المتنوع والمتكامل للطاقات الإنسانية، وناحية النظر إلى العالم خارج الذات كأداة لا تأخذ باعتبارها احترام الإنسان كمبدأ أساسي يحكم السياسات الاقتصادية، أو كقيمة مختلفة جذريا عن السلع والبضائع. هذا الخلل ينتهي إلى التعامل مع الإنسان على أنه حيوان مستهلك أكثر من التعامل معه ككيان عاقل نشط مستقل قادر على العمل الجماعي والتعاون المتبادل.
تعكس الرأسمالية نظرتها إلى الحرية على الديمقراطية لتتحول الديمقراطية إلى أداة من أدواتها. لنسأل عن عدد الإعلانات التي تظهر في وسائل الإعلام حول السلع والبضائع، وعن عددها حول رفع مستوى الوعي الإنساني وقيمة التفكير الحر والعلمي. واضح أن وسائل الإعلام التي من المفروض أن تكون مصدرا للمعرفة والترفيه وتطوير القدرات الإنسانية، يتم استغلالها بصورة كثيفة لمخاطبة الطاقة الاستهلاكية للإنسان. وواضح أن الدول الرأسمالية تستعمل الديمقراطية كأداة للنفوذ وليس كوسيلة للتأكيد على حرية الإنسان. فمثلا لم تقبل الدول الغربية الرأسمالية نتائج انتخابات الجزائر عام 1992، ورفضت نتائج انتخابات الفلسطينيين في الضفة وغزة عام 2006، وحاصرت الشعب الفلسطيني كعقاب له على اختياره. ومثلا لم تترك حكومة الولايات المتحدة الحزب الشيوعي الأمريكي يعمل، وانضم إليه عدد كبير من عملاء الأجهزة الأمنية الأمريكية، ولم تترك دول غربية عدة الفتيات المسلمات يرتدين ما يرينه مناسبا من الملابس، وإلى غير ذلك.
من الملاحظ في الدول الرأسمالية الديمقراطية أن هناك تثقيف متعمد (أدلجة) للناس لكي يكون الاستهلاك عبارة عن ثقافة، وأن ترتبط القيم الإنسانية بشكل أو بآخر بالقيم الاستهلاكية، وهذا ما يضمن للرأسمالية الاستمرار فيما هي عليه وفيه من تركيز على فكر الأرباح. هذا تثقيف يحول بين الإنسان ونفسه، ويقلل من الوعي الإنساني بالذات، وبالتالي في القوى الخارحية التي تعمل ضده، فيتحول الفرد إلى عبد وهو يظن أنه حر.
أي المطلوب هو الحرص على:
1- تحقيق الحرية كقيمة إنسانية ترتقي بالطاقات الإنسانية، أو تفتح أمامها مجالات الارتقاء من خلال التعبير عن ذاتها تصاعديا حتى المنتهى، وهي حرية ليست منبثقة من الأرباح ولا هي مقيدة بها، وإنما تحوي في داخلها حرية الإنسان في جني الأرباح كسبيل للعيش. إنها الأساس، والأرباح عبارة عن نتاج؛
2- المثابرة على التحرر من المعوقات والقيود الخارجية، الأمر الذي يرتبط مباشرة بحرية الإنسان وانبثاق طاقاته؛
3- رفع مستوى الوعي الإنساني بمفهوم الحرية وأساليب ووسائل تحقيقها، ومستوى وعيه بالعالم خارج ذاته ليكون قادرا على التعامل بذكاء معه والتغلب على المعوقات والعراقيل؛
4- ترتبط الحرية والتحررية بعلاقة جدلية تبادلية، وكلما حقق الإنسان حرية يصبح أكثر قدرة على التحرر من المعوقات الخارجية، وكلما تمكن من التحرر من قوى خارجية أصبح أكثر قدرة على التعبير عن طاقاته، والعكس صحيح.
5- العلاقة بين الحرية والتحررية توحد الذاتي والموضوعي، وتوحد الفردي والجماعي، والوعي يجعل من العلاقة بينهما علاقة ديناميكية تتميز عناصرها دون أن تنفصل. الحرية تأكيد داخلي للذات، والتحررية تأكيد خارجي للذات من خلال تطويع القوى الخارجية عن الذات أو تحييدها أو القضاء عليها. العالم داخل الذات ذاتي، والعالم خارج الذات موضوعي. وهي علاقة تحرص على الذات كفرد، وعلى الذات الجماعية للتأكيد الجماعي.
6- تطوير برامج داخلية تصنع الأجواء المناسبة لانبثاق الطاقات الإنسانية، أو لتمكين الإنسان من التعبير عن هذه الطاقات وإنمائها؛ وتطوير برامج أخرى لمواجهة العراقيل الخارجية التي تواجه الأمة والأفراد. هذا يتطلب التركيز التربوي على التفكير الحر والمنهجية العلمية، وعلى فتح المجال أمام التفاعل الفكري لرفع مستوى الوعي لدى الإنسان.
من المهم الإشارة هنا أنه يمكن تصنيف القوى الخارجية التي تعرقل حرية الإنسان إلى:
أ- قوى مرتبطة بزخم الحياة من سعي وتلاقي مصالح وأفكار أو تضاربها وتعقيد العلاقات العامة والخاصة. هذه قوى موجودة كجزء من حياة الإنسان فردا وجماعة، ويتم تناولها ضمن نشاط الحياة بصورة عامة. الإنسان يواجه المعوقات والمقيدات والهموم والضغط والتوتر بفضل كونه موجودا، وبفضل بيئته الطبيعية والإنسانية والبشرية؛
ب-قوى خارجية طبيعية لا علاقة لها بإرادة الإنسان مثل الأمراض والزلازل والأعاصير وخاصيات المعادن وتدفق الأنهار، وهي تدفع الإنسان للتفكير في كيفية السيطرة عليها أو التقليل من أضرارها، أو الاستفادة منها؛ أو اكتشاف القوانين التي تحكمها، الخ. هذه تشكل تحديات طبيعية تتطلب جهودا إنسانية لجعل حياة الإنسان أكثر طمأنينة وراحة؛
ت- قوى إنسانية على مستوى فردي أو جماعي تعمل عن قصد وتعمد على سلب حرية الإنسان وتطويعه لهذا الهدف أو ذاك. هذه القوى هي التي تشكل التحدي الحقيقي أمام إرادة الإنسان وتعرقل حريته.
التوازن بين الخاص والعام
السؤال الذي لا مفر سيبقى أمام النظام السياسي الذي يمثل الناس يتمثل في عدالة توزيع الثروة، وبطريقة لا تظلم النشطاء والأثرياء، ولا تبقي على ظاهرة الفقر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العدالة لا تعني المساواة، وإنما المساواة عبارة عن مظهر واحد من مظاهر العدالة. فمثلا، الدولة تساوي بين أبنائها في تكافؤ الفرص، أو في الرعاية الصحية، أو أمام القانون، لكنها لا تساوي بينهم في القدرات لأن قدراتهم متباينة لأسباب متعددة منها ما يتعلق بنشاط الشخص وطموحه ورغبته في تحقيق الإنجاز. العدالة تقتضي مراعاة القدرات والنشاط والإنجازات والمؤهلات الاستحقاقية، الخ. وبالتالي فإن المساواة في كل الأحوال والظروف تشكل ظلما لفئة من الناس، ومبررا للتكاسل والتواكل لفئة أخرى. أي أن العدالة في النهاية تشكل قاعدة للتحفيز، بينما المساواة المطلقة تشكل قاعدة للكسل.
أي أننا أمام هدفين لا مفر من التوفيق بينهما، أو صياغة معادلة تحققهما معا وهما: الإبقاء على المجال مفتوحا أمام النشاطات الفردية وإثبات الذات، مع حق كل من يكد ويتعب في أن يحصد، والقضاء على ظاهرة الفقر. نحن أمام إنسان له خصوصيته وتميزه دون أن ينفصل عن الآخرين، أو أمام أفراد يعبر كل واحد عن نفسه وقدراته بالطريقة التي تتلاءم مع طاقاته المنبثقة، وأمام بعد عام يصعب جدا على الفرد أن يجد نفسه بدونه. فكيف نوفق بين فرد يعبر عن خصوصيته، ولا يجد في نفس الوقت هذه الخصوصية بمعزل عن مجتمع أو جماعة؟
السؤال: هل من الممكن تحقيق توازن بين الحوافز وحسن توزيع الثروة؟ نحن بالتأكيد نريد الإبقاء على الحوافز لأننا ننشد إنتاجا أكثر وفرة وأفرادا يعبرون عن قدراتهم، ولكننا لا نريد درجة من الحوافز تنتهي بالجشع وتعيدنا إلى هوَس الأرباح؛ ونحن نريد المحافظة على حسن التوزيع إنما دون أن ننتهي إلى التواكل. الحوافز المفتوحة على غاربها تبقينا في الرأسمالية، والتوزيع الذي يغفل النشاط يبقينا في التخلف. أين هي نقطة التوازن بين تشجيع الإنتاج وعدالة التوزيع؟ وأين هي نقطة التوازن بين توفير الفرص للجميع وبين تحسين ظروف الفقراء؟
يكمن جزء كبير من الإجابة في إعادة ترتيب مفهوم الملكية الخاصة. الملكية الخاصة ما زالت تمثل مصدرا للإخلال بالاستقرار الاقتصادي والمالي على الرغم من أنها تشكل حافزا قويا لتحقيق الأرباح. ولهذا من الضروري إعادة صياغة مفهومها بطريقة لا تلغي الحوافز ولا تجعل من الأرباح قيمة عليا. الحوافز ضرورية كأداة تشجيع على العمل والإنجاز، وتحقيق بحبوحة العيش من حق كل إنسان، ومن واجب الدولة العمل على توفيرها.
إذا أردنا التخلص من الأرباح كقيمة اجتماعية واقتصادية عليا، فإن أمامنا تحديد الملكية الخاصة بأمرين وهما: التمييز بين الثروة العامة ومصادرها والثروة الخاصة ومصادرها، والتمييز بين خصخصة الثروة العامة وتأميمها. تنحصر الثروة الخاصة في كل ما ينتج عن جهد الشخص والأسرة، وكل ما ورثوه من نتاج الجهود الشخصية، وكل ما ينتج عن نشاط اقتصادي له صفة أقل من صفة عموم الناس، وكل ما يتلقوه من منح وهدايا وعطايا شخصية، وما يتلقوه من مكافآت وجوائز سواء شخصية أو رسمية (أي من الدولة أو إحدى مؤسساتها). أما الثروة العامة فتتمثل في الثروات الطبيعية وفي المؤسسات العامة المراد منها تسهيل حياة الناس عموما، وفي كل نشاط اقتصادي له صفة عموم الناس.
صفة عموم الناس تعني أن كل الناس بلا استثناء يستفيدون من النشاط الاقتصادي، وأنه من المتوقع أن يقبل الناس عموما على التعامل مع هذا النشاط. المستشفى عبارة عن مَثَل إذ أن الناس جميعا معرضون للمرض؛ وشركة الكهرباء عبارة عن مثل آخر لأن الناس جميعا يحتاجون للطاقة الكهربائية، الخ. أما بيع التفاح فعبارة عن نشاط اقتصادي لا يحمل صفة عموم الناس لأنه ليس من المتوقع أن يحتاج كل الناس التفاح أو يقبلوا على شرائه. أما بيع الطحين فعبارة عن نشاط عام لأن الناس جميعا يبحثون عن الخبز.
السلع والخدمات ذات صفة عموم الناس يبقى أصلها مؤمما، دون أن يشمل ذلك بالضرورة تفاصيل وسائل استخدامها أو إيصالها. المستشفى له صفة العمومية، لكن أدوات الجراحة تبقى ذات بعد غير عمومي. الطحين له صفة العمومية لكن الأفران يمكن أن تكون غير ذات الصفة. المستشفى لا يخضع للملكية الخاصة، لكن التجارة بمستلزمات المستشفى لا تخضع بالضرورة للملكية العامة؛ والجامعة لا تخضع للملكية الخاصة، لكن تجارة الكتب لا تخضع بالضرورة للملكية العامة، وهكذا.
أما الثروات الطبيعية مثل الأنهار والمياه الجوفية والنفط ومناجم المعادن والبحار والهواء، الخ فلا تخضع للملكية الخاصة ولا يجوز خصخصة استخراجها واستغلالها. وهنا يجب أن نميز بين ثلاثة أنواع من الثروة الطبيعية:
1- ثروة طبيعية لا يحتاج استغلالها إلى عناء، وإنما إلى جهد متواضع مثل الأنهار والبحار؛
2- ثروة طبيعية يحتاج استغلالها إلى جهود استخراجية كبيرة مثل النفط والمعادن كالحديد والنحاس والفحم؛
3- ثروة طبيعية يحتاج استغلالها إلى جهد إنساني قد يكون فيه عناء مثل الأراضي الزراعية.
بالإضافة إلى الثروات الطبيعية، هناك ثروة كامنة في طاقات الإنسان، وهي يمكن أن تنبثق وفق إرادة الإنسان الفرد على العمل. الثروة تتحقق فيما إذا قرر الإنسان العمل، وتوفرت لديه دائما العزيمة على النشاط سواء كان جسديا أو ذهنيا. طاقات الإنسان الفرد هي ملكه الخاص، وإرادته على العمل والنشاط له هو وليس لغيره، وبالتالي يملك الحق المطلق بنتاج هذه الإرادة. ربما تكون إرادته الفردية ضمن إرادة جماعية، عندها يكون حقه الفردي وفق الرؤية الجماعية. وهذا بالتأكيد ما يميز بين الأفراد من ناحية النشاط، ويتطلب إقامة العدالة عند التوزيع. لا مساواة بين النشيط والكسول، بين الذي يعمل والذي لا يعمل، بين من يجد ويجتهد وبين الذي يتمطى ويتثاءب.
الثروة الأولى عامة بطبيعتها، ويحتاج استغلالها إلى تنظيم عام من جهة عامة كجمعية زراعيين أو حكومة، أو ربما على مستوى دولي فيما يخص البحار والأنهار التي تعبر أكثر من دولة. الثروة الثانية عبارة عن ملكية عامة تقوم الدولة على استغلالها لصالح الجميع، إلا إذا كانت محدودة جدا ومحصورة في نطاق خاص مثل نبع ماء هامشي صغير. أما الثالثة وهي الأوسع نطاقا والأكثر تشعبا فمتروكة للملكية الخاصة، وفيها يظهر التنافس بين الناس.
هذا لا يعني أن أمر التمييز والتحديد يمكن حصره وفق ما ورد في الفقرتين أعلاه، بل من المتوقع أن تطرأ قضايا عديدة تبقى موضعا للجدل والأخذ والرد، وتبقى مسائل خلافية عصية على التصنيف أو صعبة التصنيف. لكن المهم هنا ليس التصنيف، وإنما المهم هو الميزان بين الحوافز وحسن التوزيع. مع كل مسألة خلاف يجب أن نجيب عن تساؤل الميزان، وبناء عليه نتخذ القرار.
بناء على ما سبق، تبقى الأمور التالية ضمن البعد العام، ولا تخضع للاستغلال الخاص أو الملكية الخاصة:
أ- تبقى الثروات الطبيعية مثل الأنهار والهواء ومناجم المعادن ملكية عامة ولا يجوز خصخصتها أو تمليكها إلا إذا كانت ضئيلة جدا لا تتناسب مع صفة عموم الناس؛
ب- تبقى المؤسسات التي تقدم خدمات عامة ذات صفة عموم الناس ملكية عامة ولا يجوز خصخصتها أو تمليكها، ومنها أذكر:
1- التعليم والصحة شأنان من شؤون الدولة ومن الضروري توفيرهما بالمجان لجميع الناس؛
2- مؤسسات الخدمات الحيوية وهي بالتحديد الاتصالات والكهرباء والماء تبقى ملكية للدولة، وعلى الدولة أن توفرها وفق معايير مالية متناسبة مع ظروف الناس.
عدا ذلك، من المهم تحديد الملكية الخاصة بسقف معين وذلك حتى لا تكون الأموال أو الثروة بيد قلة قليلة من الناس. يتحدد هذا السقف بالأمور التالية مجتمعة أو منفردة:
1- الاحتكار ممنوع لأنه يقود إلى الاستئثار والتحكم بالأسعار والكميات، الخ. هناك سلع من غير المتوقع أن تخضع للمنافسة بسبب عدم الإقبال عليها شعبيا مثل الأجهزة الطبية المتطورة أو أجهزة البث الفضائي، ومن المفروض أن تتدخل الدولة في تحديد أسعارها ومواصفاتها؛
2- تخضع المنافسة لعدد من المنتجين أو مقدمي الخدمات لا يتمكنون من تشكيل ناد خاص يتخذ قرارات بخصوص المواصفات والأسعار بعيدا عن أعين الناس والدولة ووسائل الإعلام؛
3- ظهور ثري أو أثرياء يشار إليهم بالتميز في الثراء من بين الناس. هذا لا يعني أن الثراء ممنوع، وإنما بروز شخص أو أشخاص معينين كعناصر فاحشة الثراء يعني أن احتمال استغلال الناس قد أصبح واردا من خلال التشغيل والأجور، وأن المنافسة في الإنتاج وتقديم الخدمات قد ضعفت، وأن الشخص أو الأشخاص قد أصبحوا على قوة مالية واقتصادية قد تؤثر على الوضع العام للدولة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. فضلا عن أن ظهور هذا الشخص أو الفئة القليلة قد يؤدي إلى تركيز الثروة بأيد قليلة، الأمر الذي يضر بالنشاط الاقتصادي العام والدورات الاقتصادية. أي أن الثراء مسموح ما دام ينطبق على نسبة لا بأس بها من الناس، لكن الاستثراء الذي يتخطى الثراء ويتحول فيه الثري إلى مشغل بارز للأيدي العاملة، أو إلى مصدر مالي رئيسي بارز فيلحق الضرر بالاقتصاد وبالأنسجة الأخرى في الدولة.
الدولة لا تعدم أدوات تحديد الملكية الخاصة وفق المعايير أعلاه، وبالإمكان تحديد الملكية مع المحافظة على الحوافز. هناك مثلا أداة الضريبة، وأداة قوانين التنافس التي تضعها الدولة. وهنا تبرز مسألة مهمة وهي أن التحديد يفتح مجالا واسعا أمام الفقراء ومتوسطي الحال للاستثمار مما يساهم في إزالة الفقر، وفي حسن توزيع الثروة. هذا يتعزز مع فكرة القروض التي يمكن أن تقدمها الدولة للفئات الأقل حظا من النواحي المادية، وفكرة استخدام المال كأداة لتنشيط الاقتصاد من قبل المؤسسات المالية الخاصة. الملكية الخاصة تبقى عنصرا مهما في تحفيز الناس على العمل، وكلما توزعت على أعداد متزايدة من الناس يرتفع مستوى النشاط الاقتصادي الذي يعود بالمنفعة على الجميع.
هاجم ماركس الملكية الخاصة ودعا إلى إلغائها تماما لأنها مصدر الاستغلال. هناك صحة في هجومه من حيث أن الملكية الخاصة، وفق النمط الذي ساد في عهد الإقطاع والرأسمالية التحررية، أدت إلى تركيز الثروة واستخدام الناس كأدوات إنتاجية. لكن العلة، كما أشرت سابقا، ليست في الملكية الخاصة وإنما في عدم تحديد سقف لهذه الملكية، وفي عدم مراقبة هوس الأرباح الذي رافقها. الملكية الخاصة تبقى ضرورية لتوفير حافز العمل والاجتهاد، ومهمة أيضا في التمييز بين قدرات الأفراد واستعدادتهم، وتحقيق العدالة المجتمعية.
من ناحية أخرى، لا بد أن يكون هناك سقف للأرباح التي يمكن أن يحققها النشاط الاقتصادي وذلك تبعا لماهية هذا النشاط. من الضروري لفاعلية النشاط الاقتصادي ترك الأسعار لآلية السوق، أو لقوانين العرض والطلب، لكن هذا يجب أن يصاحبه عدد من القواعد مثل منع الاحتكار أو شبه الاحتكار، ومنع اتفاق بين التجار والصناع على تحديد الأسعار خارج قوانين العرض والطلب. أما السلع والخدمات التي لا تعتمد على التنافس ولا تخضع لقوانين العرض والطلب فإنه من الضروري تحديد سقف أرباحها. فمثلا قد يُنتج مصنعٌ أدوات طبية خاصة، ولا يوجد مصنع غيره في البلاد، ولا تعمل بخصوصه آلية السوق.
التوازن بين الإنتاج والاستهلاك
السياسي الحكيم هو الذي يطور القدرات الإنتاجية لاقتصاد دولته، وهو الذي لا يسمح بسلوك استهلاكي تفوق قيمته قيمة الإنتاج. قيمة الناتج القومي يجب أن تغطي قيمة الاستهلاك زائد قيمة الاستثمار، ومن الحكمة الاقتصادية ألا يستهلك قوم كل إنتاجهم القومي، أو أن تكون نفقاتهم الاستهلاكية مساوية لقيمة إنتاجهم. السياسي الحكيم هو الذي يطلب من اقتصاديي دولته برمجة الاقتصاد بطريقة تجعل من الادخار ممكنا لكي تتوفر إمكانية الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي يفوق احتياجات النمو الطبيعي للسكان.
ولهذا من المتوقع ألا يستسلم السياسي الحر لمسألة التسابق الاستهلاكي والترويج للاستهلاك الذي يجتاح العالم، وألا يستسلم لأفكار التسويق التي تزين البضائع وتغري الناس مما يضطرهم إلى إنفاق أكثر يفوق قيمة ما ينتجون. هذا بحاجة إلى إعادة برمجة أنظمة التسويق والدعايات التسويقية، مما يعني أن الدولة ستتبنى قواعد جديدة للدعاية والترويج تحرص على أمرين وهما تعريف جمهور الناس بالمنتجات بدقة علمية، ومنع الترويج التزييني والتضليلي. من الضروري إذا أردنا حماية الناس من التلاعب وقف الحملات الإعلانية التي تقيمها الشركات للترويج لبضائعها، وإقامة مجلس خاص للتعريف بالمنتجات الجديدة ومواصفاتها ومحاسنها ومضارها.
هذا يتطلب أيضا إلغاء تدريس فن التسويق القائم حاليا لأنه يعتمد أساليب إغرائية قد تخدع المستهلك، وإلغاء فن التغليف القائم واستبداله بتغليف عملي يفي بغرض حماية السلعة. فن التغليف القائم حاليا مكلف جدا بحيث أن ثمن الغلاف قد يكون أكبر من السلعة نفسها، وفي النهاية يدفع المستهلك تكاليف التغليف وتكاليف الدعاية والإعلان.
هذا يتطلب تبني برامج ثقافية وتربوية جديدة تبث الوعي الكافي لدى الناس حول أهمية التوازن بين الإنتاج والإنفاق، وحول أهمية الاستقلال السياسي من خلال الاستقلال الاقتصادي. وعلى الحاكم أن يكون قدوة في ذلك من خلال حياة معيشية بسيطة يعيشها وبعيدا عن البهرجة والمبالغة، ومن خلال تطوير إدارة حديثة تراقب وتضبط وتمنع الفساد، وتضع قواعد المحاسبة والمساءلة الصارمة.
القوى التي تؤثر على قرارات الأشخاص الإنفاقية كثيرة جدا، وتظهر علينا جميعا باستمرار على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة، وعبر شبكة الإنترنيت، وفي الشوارع والأزقة. وكما ذكرت سابقا، هناك هجوم عنيف ومتواصل على الإنسان في كل أنحاء العالم من أجل جره إلى السوق والتهور في الإنفاق، وهو هجوم من شيم الرأسمالية. طبعا لا يوجد حل لهذه المشكلة بالانعزال عن العالم لما في ذلك من خسران لفوائد عديدة في مجالات متعددة وعلى رأسها مجال المعرفة، إنما يكمن الحل في رفع درجة مشاركة الناس في اتخاذ القرار، ورفع الوعي الوطني والقومي بالشؤون الاقتصادية. طبعا أمريكا تكره فكرة الوعي القومي والوطني، وتتعرض الدول التي تتبنى برامج رفع الوعي للضغوط على اعتبار أنها تعرقل التعاون العالمي، لكن السياسي الذي يمثل شعبه بحق يعرف أن قوته تنبع من قوة شعبه وتأييده له، وليس من خلال أمريكا وأموالها التي تؤخر ولا تقدم. ولهذا يبقى من الضروري تطوير برامج تعليمية تربوية وتثقيفية ترفع من درجة إحساس الإنسان بذاته، ورفع مستوى احترامه لذاته وكرامته والمحافظة على كيانه الشخصي الجاهز دوما للتعاون مع الآخرين وللعمل الجماعي. هذا لا يتأتى في ظل الاستبداد السياسي لأن الاستبداد نقيض الحرية ونقيض الإنسان، ولن يتأتى من خلال الديمقراطية الرأسمالية لأنها أيضا ديمقراطية الاستغلال المغلف بشعارات الحرية الحقيقية منها والتضليلية.
القروض
صنعت التسهيلات المالية التي طورتها الرأسمالية التحررية الحديثة أزمات حادة، ووضعت أعدادا متزايدة من الناس تحت وطأة الديون المتجسدة في أقساط شهرية أو دورية. طورت المؤسسات المالية والاستهلاكية نظاما ميسرا للحصول على قروض مالية أو شراء بضائع وخدمات، ورفعت بذلك من مستوى الاستهلاك الذي يفوق الدخل، أو الاستهلاك على نفقة دخل المستقبل، ورفعت نسبة المدينين ماليا وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح. ولهذا، عمقت هذه المؤسسات المالية والمؤسسات الاستهلاكية الهوة بين الإنتاج والدخل، وساهمت مساهمة كبيرة في إفقار الناس، وزيادة أزماتهم النفسية الناجمة عن هموم تسديد الفواتير والأقساط، ووضعت الاقتصاد برمته أمام خطر الانهيار.
ولهذا يجب إعادة النظر بكل مسائل الإقراض والاقتراض، والتوقف عن هذا التسيب الإقراضي. من الضروري تصنيف القروض إلى التالي:
أولا: القروض الاسترزاقية وهي القروض التي تهدف إلى مساعدة الفقراء في إقامة مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلا يستطيعون من خلاله تلبية احتياجاتهم الحياتية الأساسية مثل تعليم الأولاد والقدرة على تلقي العلاج الطبي. هذه قروض تهدف إلى إخراج الفقراء من حالة الفقر، إلى حالة يتمكنون فيها من الاقتراب من مستوى المعيشة الوسط كما هي مقدرة في الدولة المعنية.
هذه قروض ليست من صلاحية المؤسسات المالية، ولا من شأنها، إنما هي من مسؤولية الدولة. على الدولة أن تطور نظاما خاصا بهذه القروض، وتكتفي فقط بإضافة المصاريف الإدارية على القرض الذي يحصل عليه الفقير(الفقير المعرّف وفق تقدير الخبراء الاقتصاديين في الدولة) وعلى مدى معقول من الزمن متناسب مع الدخل المتوقع من المشروع.
هذا نظام من شأنه أن يجنب الفقراء تكاليف رأس المال التي تفرضها المؤسسات المالية والتي تشمل في العادة أرباحا فوق النفقات الإدارية. وبهذا يتحرر الفقراء من استغلال أصحاب الثروة الذين يتعاملون عادة مع المال كسلعة تجارية تدر أرباحا دون تحويلها إلى بضائع تجارية، أو يتحررون من سعر الفائدة الذي يكون في العادة مرتفعا.
ثانيا: القروض الإسكانية وهي القروض التي تعطيها الدولة للفقراء الذين يريدون بناء بيت كمأوى لهم ولأسرهم. من صلاحية الدولة أن تقدر احتياجات العائلة، وأن تقدر تفاصيل البيت المتواضع الذي يأوي العائلة ويسترها، وتقدم قروضا فقط للذين يستحقون ذلك. ولا يجوز بأي حال إعطاء قروض لأناس يستطيعون بناء بيت بمستوى أفضل من مستوى البيت الذي يفي بالحد الأدنى.
ثالثا: قروض الحاجات الأساسية وهي تلك القروض التي تمنحها المؤسسات المالية والاستهلاكية التابعة للدولة لشراء حاجات أساسية من البضائع المصنفة بالدائمة مثل البراد والثلاجة وفرن الغاز وما شابه. قد تكون هذه قروضا مالية مباشرة، أو على شكل أقساط.
أما القروض التي يمكن أن تُمنح للبضائع الدائمة غير الأساسية فممنوعة. فمثلا يُمنع منح قرض مالي أو البيع بالتقسيط لشراء سيارة خاصة لا هدف إنتاجي لها. ألف صحة لمن يملك مالا يكفيه لشراء سيارة، لكن يجب حظر شراء السيارات بالتقسيط وذلك للحيلولة دون المديونية القائمة على الاستهلاك غير الضروري.
رابعا: القروض الاستثمارية وهي التي تمنحها المؤسسات المالية التابعة للدولة لمن هم ليسوا فقراء، ويرغبون في تطوير مشاريع اقتصادية وخدمات ترفع من دخلهم المالي وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني. تخضع هذه القروض لمعايير ضرورية لضمان سير الاستثمار مع ضمان حقوق المؤسسة المالية. وربما يتساءل أحد هنا عن مثل هذا الاستثمار الذي يعيدنا إلى فكرة الرأسمالية التحررية. لا، هذا لن يعيدنا لأن الضمانات في كلا الاتجاهين يجب أن تكون كافية، ويجب أن تكون تحت وطأة القانون المنظم للعمل الاستثماري. ومن ناحية أخرى، تشكل هذه القروض حوافز كبيرة أمام المستثمرين، وتساهم في تنوع المشاريع الاقتصادية. وهنا يمكن الاستفادة من فكرة المرابحة لما فيها من حرص على التدقيق المالي.
خامسا: القروض الاستثرائية وهي تلك التي يقوى الأثرياء جدا فقط على الحصول عليها. هذه قروض ممنوعة، وذلك وفق معايير تضعها الدولة لتحديد الاستثراء، والتمييز بينه وبين الاستثمار والاسترزاق. قروض من هذا القبيل تزيد الأثرياء ثراء، وتؤدي في النهاية إلى تركيز المال بيد فئة قليلة من الناس. من وظيفة الدولة أن تشجع الاستثمار، وتحول دون الاحتكار، وتمنع الثراء الفاحش الذي قد يستحوذ على الناس ويشكل سلطة قوية متسلطة، وهيمنة اقتصادية. هذا إجراء من شأنه أن يحول دون غلواء الملكية الخاصة، والإبقاء على فرص التملك أمام الجميع.
هنا أشير إلى أن تجارة المال قد جرت الكثير من الهموم على الناس، وشجعت المضاربات والمقامرة، وأدت في النهاية إلى ظهور مؤسسات مالية كبيرة جشعة. أدى ظهور هذه المؤسسات إما إلى انتعاش مالي كبير تغذى على مصالح الناس، أو إلى انهيار قضى على مدخرات الكثير من الناس. تجارة المال عبارة عن عمل لا اقتصادي وإنما عمل طفيلي، وهو غير منتج بالرغم من الخدمات التي يقدمها. بإمكان الدولة أن تقوم بذات الخدمات لكن دونما تعريض الناس للاستغلال أو الإفلاس. المعنى أن المؤسسات المالية الخاصة غير ضرورية، ومن المطلوب أن تطور الدولة مؤسسات مالية تساهم في مساعدة الناس اقتصاديا، ودعم المشاريع الاقتصادية التنموية.
تجارة المال مضرة بالمجتمع لأنها في النهاية أقرب إلى القمار من النشاط الاقتصادي، ومن المهم أن يتم تطوير مؤسسات مالية تسهل الأعمال التجارية والمبادلات، وتسهل نقل الأموال وتحويلها، وتبتعد عن استعمال المال (أعني النقود وليس الثروة بعمومها) كسلعة تجارية. المال عبارة عن أداة وليس سلعة، وهو أداة للتسهيل وليس لصناعة الهموم للناس. ولهذا من المتوقع، إذا أردنا تجنب الهزات المالية أن تطور الدولة مؤسسات مالية لتنشيط الأعمال الاقتصادية الاستثمارية منها خاصة، وأن تسمح بإقامة مؤسسات مالية خاصة تأذن باستخدام المال كأداة تجارية وليس كسلعة تجارية. أي أن المصارف والمؤسسات المالية القائمة حاليا وفق الأسس الرأسمالية تشكل مصدرا لعدم الاستقرار ولاستغلال الناس.
قد يجادل أحدهم أن مثل هذا الإجراء يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يؤثر سلبا على الدخول الفردية للأثرياء والفقراء. من المحتمل أن يحصل تباطؤ، ومن المحتمل ألا يتحقق النمو المطلوب، لكننا دائما أمام سؤال كبير وهو: هل نركز على النمو مع إغفال معايير العدالة أو جزء منها، أم نضحي ببعض النمو من أجل العدالة؟ علما أن العدالة ترفع من معنويات الناس، ومن تكاتفهم وتضامنهم، وترفع من مستوى العمل الجماعي والتعاون المتبادل.
من المتوقع أن يكون التنافس الإنتاجي في ظل هذه الأسس المطروحة في هذه الورقة على مستوى أفضل من التنافس القائم في ظل الرأسمالية ذلك لأن المجال مفتوح أمام أعداد أكبر من المتنافسين، ولأن حيتان المال غير مسموح لهم بالظهور.
المستوى الدولي
على المستوى الدولي هناك أمران:
أولا: تحرير التجارة العالمية لا يخدم إلا الشركات العالمية والدول التي ترعاها، وهو ميل عالمي للاحتكار لأنه من الصعب جدا منافسة تلك الشركات. تحرير التجارة العالمية يخدم بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، وجزئيا أوروبا واليابان والصين، ولكنه يؤثر سلبا على الدول النامية. التجارة العالمية الحرة تتجه بالعالم نحو مركزة مكثفة للثروة، وانتشار واسع للفقر، وبالثري نحو مزيد من الثروة، وبالفقير نحو مزيد من الفقر. ومن الواضح وفق التقديرات العالمية أن أعداد الفقراء الجياع في العالم تتزايد، وأعداد سكان العشش يتكاثرون، وأعداد الأطفال الضائعين في ارتفاع.
تجد الآن أمريكا نفسها في موقع قوة وسطوة على الأمم، وهي تعمل منذ سنوات على عولمة الاقتصاد العالمي بحيث يصبح تحت رحمة الاقتصاد الأمريكي وفي خدمته. أمريكا لا مانع لديها لتحطيم اقتصاديات دول العالم، وتحويل شعوب كثيرة إلى مجرد شعوب متسولة تدين لأمريكا بالولاء والطاعة مقابل لقمة الخبز. وإذا كان لشعوب الأرض أن تطور اقتصاديات وطنية قادرة على التعاون مع الاقتصاديات الأخرى فإن عليها مواجهة الهيمنة الأمريكية، وإبعاد الجشع الأمريكي عن الساحة العالمية. أمريكا الآن هي سبب قوي وأساسي ورئيسي في الفوضى الاقتصادية العالمية نتيجة لنظامها الاقتصادي القائم حاليا وهو النظام الرأسمالي التحرري الحديث. لقد حققت أمريكا تقدما تقنيا واقتصاديا هائلا بحيث ترى في الرأسمالية التحررية (الليبرالية) فرصة للسيطرة السهلة على مقدرات وثروات الأمم.
ثانيا: من الخطأ عزل الاقتصاد الوطني أو القومي عن اقتصاديات الدول الأخرى، لكن ذلك يجب أن ينضبط بأمرين وهما المحافظة على القوة الإنتاجية للاقتصاد القومي، والتعاون على أسس العالمية وليس العولمة. المحافظة على القوة الإنتاجية ورفع مستواها مهم من أجل توفير فرص العمل الحقيقية، ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، أما العالمية فمن أجل الحرص على التكامل الدولي دون ذوبان اقتصاد لحساب اقتصاد آخر. ولهذا من الضروري مراجعة كل معاهدات التجارة الحرة لتأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي الذي يحرص على استقلال الدول وسلامة اقتصادياتها الإنتاجية وحمايتها من هجمة الاقتصاديات الضخمة والشركات الكبرى.
وإذا كان للدول النامية أو المتضررة من الترتيبات الاقتصادية المعولمة أن تنمو فإن عليها أن تتخلى عن أفكار القروض التي مصدرها المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. هذان مصرفان يمثلان أداتين قويتين للتحكم في اقتصاديات الأمم، وهما يضعان شروطا قاسية باستمرار من أجل تجريد الأمم من استقلالها الاقتصادي النسبي، وتحويله إلى اقتصاد تابع. وإذا كان للدولة أن تحقق نجاحا اقتصاديا فإن من واجبها الحرص على استقلالها السياسي من خلال استقلالها الاقتصادي الحر من القروض.
تكمن علة كبيرة في حكام الدول النامية، أو بالأحرى في الغالبية الساحقة منهم لأن اهتمامهم لا يبدو منصبا على مصالح دولهم وشعوبهم وإنما على مصالحهم الخاصة. تقدم أمريكا لهم الإغراءات المالية والترفيهية، وتوفر لهم الحماية الأمنية والعسكرية، ومقابل ذلك يطوعون أنفسهم ودولهم لخدمة السياسة الأمركية. خدمة دولهم تتطلب السهر والتعب والعمل الدؤوب، وخدمة أمريكا لا تتطلب سوى الاسترخاء والاعتماد على الشركات الأمريكية في إنهاك الناس وتحويل أنظارهم إلى غير الوجهة الصحيحة، إلى البحث عن المال الثراء ولو على حساب الصالح العام للأمة. أي أن أغلب الحكام في الدول النامية عبارة عن أدوات، وهم ليسوا أصحاب قرار، وكل النصائح التي يمكن تقديمها لهم من أجل الإصلاح لن تجدي نفعا، وقد تودي بمقديميها إلى الهلاك.
الهوة الاستهلاكية والهوة العلمية
حققت الدول الصناعية المتطورة مستوى استهلاكيا عاليا يفوق بكثير المستوى الاستهلاكي في الدول النامية والتي تشكل الأغلبية الساحقة من دول العالم. هناك هوة واسعة جدا بين المستوى الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا وذلك المتوفر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأغلب اقطار آسيا. وهناك هوة كبيرة أيضا بين المستويين العلمي والتقني في الدول المتطورة صناعيا وتانك في الدول النامية. الدول الصناعية متطورة علميا، ومكتشفاتها العلمية تتطور يوما بعد يوم، وتبعا لذلك تتطور قدراتها التقنية والتي تمكنها من المزيد من الإنتاج ومن المزيد من الهيمنة على المستوى العالمي.
ما تقوم به الدول الصناعية المتطورة بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هو تضييق الفجوة الاستهلاكية بينها وبين الدول النامية في حين أنها لا تحاول تضييق الهوتين العلمية والتقنية، بل تمتنع الدول الصناعية في أغلب الأحيان عن تقديم العون العلمي للدول النامية، وتبقي المكتشفات سرا لا يُفصح عنها إلا ربما بعد حين حتى تبقى هي القادرة على تقديم الجديد من المخترعات وتبقى الدول النامية مستهلكة لها دون حتى أن تتوفر لديها القدرة العالية على صيانة ما تستورد.
لهذا تنشط الدول الصناعية الكبرى في مجال تحرير التجارة العالمية وفتح الأسواق العالمية أمام ما تسميه المنافسة، وكذلك في أعمال الدعاية والإعلان من أجل تحويل الدول النامية إلى مجرد دول مستهلكة لا تقوى على المنافسة. ولهذا يمكن أن نرى أن الهوة الاستهلاكية مردومة إلى حد كبير بين الدول الصناعية وبعض الدول النامية الثرية مثل دول الخليج التي تستورد الكثير من المخترعات والبضائع الجديدة قبل أن تتوفر في السوق المحلية للدولة الصانعة. فمثلا نجد آخر صيحات السيارات في دولة الإمارات قبل أن نراها في شوارع نيو يورك أو لندن، وربما أيضا بعض الجواهر والعطور في جدة قبل توفرها في باريس.
واضح أن الهوة الاستهلاكية بين الدول الصناعية المتطورة والدول النامية أقل اتساعا من الهوة العلمية والتقنية بين المتطورين والنامين. وهذا هو الغرض النهائي من الانفتاح التجاري الذي تصر عليه دول التصدير، والذي هو تسويق بضائعها على حساب بضائع الاقتصاديات الضعيفة. وإذا كان للدول الصناعية الكبرى أن تصدر بضائعها إلى أغلب الدول الأقل إنتاجا أو أقل تطورا، فإنها تستنزف دخول من تتوقعهم أن يكونوا مستهلكين، ولهذا تلجأ إلى إقامة مصانعها في الدول النامية. إنها تعطل إنتاج الدول النامية، وتحول الناس إلى عمال، والاقتصاد إلى تابع، وتحاصر بالتالي كل إمكانية للنهوض والمنافسة. عند هذه النقطة تفقد الدول النامية كل مبرر للتطوير العلمي والتقني، وتصبح مجرد دول تابعة لا تملك قراريها الاقتصادي والسياسي.
من الجدير ذكره هنا هو أن مستوى الاستهلاك في الدول الصناعية قد ارتفع تبعا لارتفاع مستوى الإنتاج؛ أي أن شعوب الدول الصناعية والمتطورة اقتصاديا أخذت تستهلك أكثر وتحصل على منتجات استهلاكية أفضل من ناحية النوعية مع تطور الإنتاج، والعلاقة استمرت طردية بين الارتفاع في مستوى الإنتاج ومستوى الاستهلاك من السلع والخدمات. كانت تلك الدول تدخر جزءا من دخلها وتستثمر، ولو كانت غارقة في الاستهلاك دون اكتراث بالاستثمار لما استطاعت تحقيق ارتفاع في الإنتاج، ولم يكن لدخول أبنائها أن تتحسن مع الزمن.
وإذا نظرنا إلى سيرة الدول التي عملت بجد نحو البناء الاقتصادي المتين والمتصاعد لوجدنا أنها ركزت على محاصرة الاستهلاك بطريقة أو بأخرى من أجل أن توفر المال الكافي للاستثمار، وكان التوفير ضروريا من أجل مستوى استهلاكي أفضل في المستقبل، ولو لم تفعل تلك الدول ذلك لما استطاعت أن تشق طريقها الاقتصادي نحو النجاح. قد تبدو الدول التي تدخر من أجل الاستثمار أقل رفاهية من الدول التي لا تضع خططا استراتيجية لإبقاء قيمة الاستهلاك دون مستوى قيمة الإنتاج، لكنها هي الدول التي تحاول تأمين مستقبلها وحماية اقتصادها من الانهيار أو التبعية أو التبذير.
لكن من الملاحظ، وكما أشرت سابقا، أن عددا من الدول الصناعية، أو التي أصبحت في مرحلة ما بعد الصناعة كالولايات المتحدة، لم تعد تكترث بالمحافظة على معادلة استهلاك أقل من الدخل، فوقعت في مطبات اقتصادية متعددة على رأسها الأزمة المالية العالمية التي بدأت تهدد الاقتصاد العالمي عام 2008. فتحت هذه الدول المجال للإنفاق ولو كان بالمديونية، فاختل التوازن، وحصلت الأزمة التي أصابت كل دولة وكل فرد في العالم، إلا أولئك الذين لا يملكون.
الأهم بالنسبة للدول النامية من أجل أن تتقدم اقتصاديا هو إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالضبط كما لدى الفرد العادي أن يعمل. الدول التي يزيد استهلاكها عن إنتاجها تتورط بالديون، أو تضطر للمساومة على إرادتها السياسية من أجل الحصول على مساعدات مالية واقتصادية من دول أخرى. على الدولة إبقاء استهلاكها وادخارها متوازنا تماما مع إنتاجها، وإلا فإن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستتدهور، ويصبح تدارك الأمر أكثر صعوبة مع مرور الأيام. ولهذا من المهم أن يكون لدى الدولة سياسة استهلاكية يشارك في صنعها جمهور الناس مترافقة مع سياستها الإنتاجية. ودائما نتذكر أن العلاقة طردية بين الإنتاج والاستهلاك، وليس العكس. من المتوقع أن يرتفع المستوى الاستهلاكي كلما زاد الإنتاج، لكنه ليس من المتوقع أن يزداد الإنتاج كلما زاد الاستهلاك.
من الضروري أن يشارك الناس جميعا في صناعة السياسة الاستهلاكية حتى تقلل الدولة من احتمالات وكثافة عملية تهريب البضائع، وانتشار السوق السوداء. لن تتمكن الدولة من صناعة سياسة استهلاكية واعية بدون جمهور واع لأهمية الأمر، ودون أن ترفع من مستوى إدراك الأفراد والأسر بأهمية العمل الآن من أجل مستوى استهلاكي أفضل في المستقبل. وفي هذا لا بد أن نعي أن الانفتاح العالمي من خلال وسائل الاتصال والمواصلات ووسائل الإعلام يجعل من الصعب صياغة سياسة استهلاكية بدون وعي الناس بأهميتها. الانفتاح العالمي القائم حاليا والذي يتناسب مع الاقتصاديات المتطورة جدا وبالأخص اقتصاد الولايات المتحدة، لا يتناسب مع اقتصاديات الدول النامية لأنه انفتاح يشجع على الاستهلاك، ويطلب من الناس أن يبقوا في السوق يشترون آخر المنتجات وآخر الصيحات.
ينطبق هذا الأمر أيضا على الخدمات إذ يجب أن يتوازن تطور الخدمات مع تطور الإنتاج. خلل كبير يصيب الاقتصاد إذا تطور مستوى الخدمات عن مستوى الإنتاج لأن ذلك يعني في الغالب اقتراض أموال والغرق في الديون.
هذا يعني أن أسواق الدولة يجب ألا تكون مفتوحة أمام ما هب ودب من البضائع، وعلى الدول النامية ألا تستجيب لضغوط الدول المتقدمة صناعيا وتفتح أسواقها تحت شعارات اقتصادية كاذبة. فتح أبواب الأسواق المحلية أمام المنتجات العالمية المتنوعة يلحق أضرارا بالاقتصاد المحلي إن لم يكن اقتصادا قويا منافسا، ويحول الدولة إلى دولة مستهلكة غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الهجمات الاستهلاكية التي تغزو مواطنيها، فتغرق بالديون، ومن ثم بالتبعية السياسية وربما تصبح تحت الحماية الأمنية أو العسكرية. التعاون الدولي مهم، لكن يجب ألا يتم على حساب كيان الدولة وخير شعبها.
الإدارة
حتى يكون بالإمكان تطبيق المعايير الاقتصادية بحرص وبمستوى متصاعد من الكفاءة فإنه من المفروض تطوير أساليب إدارية تتطور باستمرار. وهنا أشير إلى مشكلتين كبيرتين تسودان الساحة العالمية وتؤثران سلبا على الكفاءة الإدارية وهما مشكلة الجشع والطمع التي تسيطر على عقلية كبار الإداريين في الدول المتقدمة اقتصاديا، وعقلية الفساد والإفساد التي تسيطر على الغالبية الساحقة من قادة الدول النامية. ينشغل الإداريون في الدول المتطورة، ومعهم السياسيون والاقتصاديون في أمور الأرباح كثيرا، وغالبا ما يسيطر عليهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بخاصة فيما يتعلق بالنشاطات العالمية؛ وكما أشرت سابقا، ينشغل المتمسكون بالأرباح كقيمة عليا كثيرا في البحث عن ثغرات في القانون من أجل تجنب ما يكبح أطماعهم وجشعهم. إدارة تنطلق من مبدأ الأرباح، ومن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح لا يمكن أن تعمل بكفاءة عالية وفق معايير إنسانية ذلك لأن الغاية لا مفر تصطدم تكرارا مع الأبعاد الإنسانية.
أما في الدول النامية فالآفة السياسية ليست فقط في السياسة الاستغلالية من قبل الدول المتطورة اقتصاديا والقوية عسكريا، وإنما من حكامها ومعاونيهم الذين يحترفون الاختلاس والسرقة والتحايل ويجمعون ثروات هائلة على حساب الشعوب. من الملاحظ في أغلب الدول النامية أن الحاكم ثري جدا وربما ملياردير، لكن شعبه فقير ومنهم من يموت من الجوع. الفساد الإداري يأكل الكثير من ثروات الشعوب، ويمنع عنها العمل الجاد الهادف إلى التطوير في مختلف مجالات الحياة، ويؤدي إلى تدهور المستوى الأخلاقي لدى الناس، وإلى التفسخ الاجتماعي وإضعاف الرغبة في العمل الجماعي والتعاون المتبادل. الغالبية الساحقة من حكام الدول النامية عبارة عن مجرمين بحقوق شعوبهم، ولا يوجد من يحاسبهم. ربما يوجد هناك من يقتلهم أو يقلب الطاولة على رؤوسهم، لكن قوانين المساءلة والمحاسبة غائبة إلى حد كبير، وإلى حد أن القضاء في هذه الدول معطل أو يواجه مشاكل كبيرة تحول دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة.
الحكام الفاسدون لا يقومهم أو يستبدلهم بمن هم أفضل منهم إلا الشعوب. ربما تتدخل أحيانا هيئات دولية من أجل التأثير على الحكام، وربما تتدخل دول، لكن كل ذلك يتضاءل أمام إصرار الشعب على تصحيح عمل الحكام، أو التخلص منهم إن أبوا. لكن المشكلة تكمن أيضا في الشعب إذا كان ميتا، أو غير قادر على الحراك الجماعي في مواجهة الظلم. في هذه الحالة، يلجأ كل شخص في الغالب إلى حل مشاكله بمفرده وبطريقته الخاصة بمعزل عن الآخرين، وذلك من خلال التحايل والنفاق والوساطات والمحسوبيات، والتي تعتبر ركنا فساديا أساسيا في تخريب الدولة والناس معا. هذا يعني أن المسؤولية تقع على عاتق المثقفين والمفكرين الذين من واجبهم بث الوعي الجماهيري من أجل تحقيق التغيير نحو الأفضل.
أما في الدول المتطورة، فهناك إدارة حديثة إلى حد كبير، لكن من الضروري أن تتخلص من فلسفة الرأسمالية الليبرالية الحديثة وتتستند إلى أسس إنسانية تراعي المصلحة العامة، ومصالح مختلف فئات المجتمع. وإذا كان للدول المتطورة أن تحقق إدارة حديثة ذات بعد إنساني فإن عليها أيضا القضاء على الطفيليين الذين يحققون ثراء دون أدنى جهد. السماسرة عبارة عن طفيليين، وكذلك أصحاب العمولات، والوسطاء، وهؤلاء يحققون أرباحا على حساب جماهير الناس في كل مكان.
من المهم في الشأن الإداري إبعاد الإدارة عن التسييس. في كثير من الدول، الإدارة موجودة وفق نظام آيديولوجي، أو من أجل خدمة أهداف النظام السياسي الحاكم الحزبي أو القبلي، الخ. الإدارة يجب أن تلتزم بمعايير خدمة الناس وتصريف شؤونهم اليومية والمدنية بغض النظر عن الأهواء السياسية أو الصراعات والتحزبات، ولهذا يجب أن يقوم عليها أناس ينتمون لأوطانهم وشعوبهم وليس لأحزابهم أو قبائلهم. الإدارة تفسد بسهولة إذا تم تسييسها لأن هدفها يتحول من خدمة الناس إلى خدمة الفئة السياسية الحاكمة أو المتنفذة، وقد أفسد التسييس مؤسسات كثيرة وأدى إلى إحباط الناس وعزوفهم عن المشاركة في الأعمال العامة. الإدارة يجب أن تلتزم فقط بالأسس المهنية، وتطورها يجب أن يتم وفق الأسس المهنية.
هذا ومن المهم الانتباه إلى أن تحول الإدارة إلى بيروقراطية يقوم عليها أناس طالت أمد عملهم في وظيفة معينة يؤدي إلى التأثير غير المحمود على النظام السياسي، وقد يعرقل عمله. ولهذا لا بد من تطوير إدارة مرنة تعمل دائما على إحداث تنقلات في الطواقم الإدارية بحيث لا يبقى الموظف في وظيفته لسنوات طويلة، ولا المدير مديرا لفترات طويلا.
المستوى الأخلاقي
الكذب في الرأسمالية الليبرالية ممنوع، والقانون يطال الكاذبين ليس لأسباب إنسانية وإنما لأسباب تتعلق بحسن سير النظام الرأسمالي؛ أما الزنا فغير ممنوع، بل العهر عبارة عن تجارة مشروعة ليس رأفة بالساقطين، ولكن من أجل حسن سير النظام. في كلتا الحالتين، الأرباح هي المحرك. من الناحية الإنسانية، الكذب غير مقبول، وكذلك العهر. فهل بالإمكان التحول عن الأخلاق الربحية إلى أخلاق إنسانية؟
الأخلاق الإنسانية تأذن بالأرباح، وتعترف بحق كل إنسان في أن يجني ثمار عمله، وفي نفس الوقت تحرم الكذب والزنا لما فيهما من تأثير سلبي على النسيجين الاجتماعي والأخلاقي. الدعارة تحقق أرباحا مالية للداعر، لكنها تسبب خسائر جمة على مستوى الترابط الأسري، وتسيء إلى الاحترام المتبادل بين الأزواج، وتشكل خطرا كبيرا على حيوية الضمير الإنساني واحترام الشخص لذاته. فهل أضحي بالمجتمع، أو هل أسيء للمجتمع، من أجل حفنة من الداعرين الذين يبحثون عن المال؟ وبأي حق يستغل داعر حاجة امرأة للمال فيطوع جسدها لمن غلبتهم الشهوة وملكوا المال؟ من المفروض أننا في عالم يحترم المرأة، ويقدر حرية الإنسان، فهل هذا المفروض معمول به من قبل من يجيزون بيوت الدعارة والشذوذ؟
ما أريد قوله أن هدف المجتمعات يجب أن يكون التقدم في مختلف مجالات الحياة، وألا يحصل تقدم في مجال على حساب مجال آخر، وأن فكرة التوازن بين مختلف النشاطات والأهداف يجب أن تأخذ حقها نحو التطبيق العملي. من الضروري أن نحقق تقدما اقتصاديا، وأن يرتفع مستوى المعيشة، وأن يتحسن مستوى الاستهلاك، لكنه من الضروري أيضا التمسك بعدالة التوزيع، وبتماسك المجتمع، وبتحسين الظروف الصحية والتعليمية لكل الناس، وبإقامة حكم قانون قائم على شرائع تستند إلى فلسفة الحق وليس فلسفة الربح. أي أن التوازن بين مختلف النشاطات يشكل القاعدة الأخلاقية الأساسية التي تقود الناس إلى وضع معيشي مادي ومعنوي متطور، ويتقدم باستمرار.
هل نحن نسعى إلى تحقيق رفاه (رفاء) قد يحصل عليه جزء من الناس، أم إلى إقامة عدالة يستفيد منها كل الناس؟ هل الرفاه يؤدي إلى العدالة، أم العدالة تنتهي في النهاية إلى رفاه؟ الرفاه لا يؤدي بالضرورة إلى عدالة إلا إذا كان هدفه خارج ذاته، أي إلا إذا كان هدفه أسمى منه وهو العدالة. لكن هل من الممكن تحقيق الهدف الأسمى من خلال الهدف الأدنى؟ المنطق هو أن الهدف الأسمى يؤدي إلى تحقيق الأدنى لأن الهدف الأسمى متعدد الفروع ويغذيها جميعا بذات الرؤية أو ذات الفلسفة. الرفاه مهم، لكنه قد لا ينطلق من فلسفة شاملة للعدالة فيبقى ضمن حيز ذاته، وقد تنقلب نتائجه سلبا على العموم، لكن العدالة تحمل مفاهيم عامة يسعى الجميع حكاما ومحكومين إلى تطبيقها. وبما أن الناس يشاركون في تطبيق المفاهيم التي يرون فيها تعبيرا عن العدالة فإن قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل تبقى سائدة، وفيها ينتقل الشعب أو الأمة من مستوى إلى مستوى أرقى أو أفضل. قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل تشكل القاعدة الأساسية لنهوض أي أمة لأنها تعبر عن أخلاق الإنتاج وحسن الأداء وكفاءة التوزيع ونشر الطمأنينة لدى الناس جميعا.
في معايير العدالة، هناك توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بين الملكية العامة والخاصة، بين الأرباح والحق في العيش وتحسين ظروف المعيشة، بين مصالح مختلف فئات المجتمع، بين زيادة الثروة وحسن التوزيع، بين الإنتاج والاستهلاك، بين الإنتاج والخدمات، بين نفقات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بين التمايز في القدرات والدخل المادي الذي يحصل عليه الإنسان، بين المتطلبات المادية للإنسان والمتطلبات المعنوية، الخ. الإخلال بنقاط التوازن يشكل إخلالا بعصب الحياة مما يؤدي إلى اضطرابات ونكسات وفوضى، وربما إلى انهيار، وإذا كان للإنسان أن يتقدم بقدر قليل من المآزق المعنوية والمادية فإن نقاط التوازن بين مختلف نشاطاته وتطلعاته وآماله وإمكاناته هي المرتكز.
وهل تقود نقاط التوازن هذه إلى تحقيق الفضائل الأساسية التي أجمعت عليها أغلب الحضارات والأديان والفلسفات مثل الصدق والوفاء بالعهد والوعد وأداء الأمانة؟ نعم بالتأكيد لأنه من غير الممكن أن تقوم نقطة توازن بين رذيلة وفضيلة لأن العلاقة بينهما علاقة نفي، وإنما تقوم فقط بين رذيلة ورذيلة، أو بين فضيلة وفضيلة. لا توجد نقطة توازن بين الكذب واحترام الآخرين، ولا نقطة توازن بين السرقة والإحسان؛ إنما هناك نقطة توازن بين الاعتداد بالذات واحترام الآخرين، بين السرقة والكذب، بين كسب العيش وحسن التوزيع، بين الجشع وإفقار الآخرين. فإذا اتبعت الأمم نقاط توازن من أجل تحقيق التقدم, فهي حتما ستقيم نقاط توازن بين مختلف الفضائل لأن التقدم بالتعريف عبارة عن فضيلة.
من المهم التمييز هنا بين الخلق أو الأخلاق القيمية، والأخلاق أو الأخلاق التطويرية. يتعلق الخلق ببيئة معينة أو ثقافة معينة وتدخل ضمنه ما يعتبره ذلك المجتمع المعين قيما مقبولة، وما يعتبره قيما غير مقبولة. معايير القبول وعدم القبول تتعدد بتعدد المجتمعات والثقافات، وقد تلتقي بعض الثقافات عند معايير معينة وقد تختلف عند أخرى. المهم أن الخلق يميز مجتمعا أو ثقافة بحد ذاتها، ويصعب تعميمه على المجتمعات الأخرى. أما الأخلاق التطويرية فعبارة عن قيم عليا عالمية، بل وربما تكون كونية، وهي ليست حكرا على ثقافة دون أخرى. فمثلا الصدق عبارة عن أخلاق تطويرية، وكذلك الوفاء بالعهد والوعد، وتوفير الفرص المتكافئة للناس جميعا، والمساواة فيما بينهم أمام القانون. هذه قيم أخلاقية لا تصلح المجتمعات ولا تتطور بدونها، وهي قد تلتقي مع الخلق الخاص بثقافة معينة، وقد لا تلتقي.
لمزيد من التوضيح، أشير إلى أن مبدأ التعليم حق لكل فرد عبارة عن أخلاق عالمية، ولا يوجد مجتمع يتطلع نحو التقدم والتطوير لا يتبنى هذا المبدأ. وكذلك مبدأ الامتناع عن القتل بغير دفاع عن النفس، ومبدأ الإحجام عن الفساد والإفساد، ومبدأ الامتناع عن شهادة الزور والتمسك بقول الحق، ومبدأ القسط بين الناس، والعدل فيما بينهم، ومبدأ حفظ الأمانة والامتناع عن السرقة، وأكل أموال الآخرين. هذه جميعها مبادئ أو أخلاق عالمية، ولا يوجد فلسفة أو دين أو عقيدة يمكن أن تتبنى نقيضها، أو تدعو إلى العمل ضدها.
إذا تناقض الخلق مع الأخلاق فإن الأولوية للأخلاق لأن العالمي فوق المحلي، ولأن الأرقى فوق الأدنى، ولأن المبدأ يتقدم على العادة والتقليد. وإذا كان لنظام اقتصادي أو سياسي أن يتمسك بخلق ثقافته فقط حتى لو تناقض مع الأخلاق التطويرية فإنه سيسقط في سوء تقديره، وسيصعب عليه التقدم في مختلف مجالات الحياة. هناك مجتمعات تمتهن الكذب والمغيبة، وهما جزءا من ثقافتها، لكن هذه القيم غير مقبولة من ناحية الأخلاق التطويرية، وأثرها بالتأكيد تدميري على من يمتهنها. وهناك مجتمعات تفضل النوم والقعود على العمل والنشاط، وهي بذلك تبقى فقيرة وشعبها خلف الشعوب.
وعليه، إذا كان للعالم الرأسمالي أن يبقى على ما هو فيه فإن الباب مفتوح أمام الشعوب والأمم الأخرى أن تفكر مليا بما هي فيه، وتعيد حساباتها ليس وفق الإملاءات والرغبات الأمريكية، ولكن وفق ما يتناسب مع مصالحها وليس مصالح حكامها القائمين حاليا. وإذا كان للأمم النامية أو الشعوب المضطهدة والفقيرة أن تنعتق فإن أمامها صحوة أخلاقية تقود إلى صحوة إدارية ترفع من مستوى توظيف المصادر الطبيعية والإمكانات البشرية والإنسانية، وتخلصها من الهزات الاقتصادية والأخلاقية التي تعصف بالعالم أجمع.
الانعكاس التربوي للمنطلقات الأساسية
يصنع كل نظام فلسفي لنفسه مناخا تربويا ينبثق من المنطلقات أو الركائز الفلسفية الأساسية للنظام، ذلك لأن النظام الفلسفي يقدم منهج حياة يمس مختلف المجالات والظروف. فالنظام الذي يؤمن بأن الإنسان خير بالطبيعة كركيزة فلسفية يعتبرها حقيقة مطلقة يعمل على ترتيب المناهج التربوية سواء في رياض الأطفال أو المدارس أو وسائل الإعلام وفق هذه الرؤية للإنسان، فيفترض الخير كمحرك أساسي للسلوك الإنساني ولإقامة العلاقات الاجتماعية والعامة. أما النظام الذي يؤمن بأن الإنسان شرير فإنه يقوم بترتيبات تربوية مغايرة تماما. الأول يدعو إلى الثقة بالناس والاطمئنان إليهم، ويشجع على الإيثار والكرم وحب الآخرين، أما الثاني فيرفض الثقة بالناس، ويفترض الشك كأساس في إقامة العلاقات الإنسانية، ويمجد البخل والأنانية والاحتراز المستمر ضد العدوان.
هذا واضح أيضا في النظام الذي ينطلق من مبدأ التوحيد بالله عز وجل إذ يعمل على تطوير برامج تربوية تعزز الإيمان بالله، وتجعل من عمل الإنسان عملا هادفا وموجها نحو كسب مرضاة الله. أي أن رضا الله يشكل القاعدة الإنسانية التي يبني عليها المرء أعماله وأفعاله، والفوز بالآخرة يبقى الهدف النهائي. ولهذا يركز النظام التربوي بصورة أساسية على وحدة المؤمنين والتسليم بالشرائع والتعاليم السماوية، وتعاونهم من أجل إقامة دين الله على الأرض. ولهذا يتعلم المرء قيم نفي الذات، والتضحية في سبيل الله وحب الآخرين كجزء من محبة الله.
هذا ينطبق على الرأسمالية التي تنطلق من الفردية والتحررية في بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعتبر أن الفرد هو الأساس في عملية البناء العام لأنه يحرص على بناء ذاته. ولهذا نرى الرأسمالية مهتمة جدا في فتح الفرص أمام الناس للمنافسة والإنجاز والإبداع. ومن حيث أن القيمة العليا لديها هي تحقيق المزيد من الأرباح فإن البرامج التربوية تأخذ عادة أبعادا مادية كمقياس للالتزام والصالح العام. الأرباح قيمة عليا تجعل من الإبداع طريقا نحو الإنجاز المادي، وبها يقاس النجاح.
المناخ التربوي المنسجم مع ما تطرح هذه المقطوعة الفكرية هو ذلك الذي من شأنه توفير الأجواء المناسبة لانبثاق الطاقات الإنسانية المعنوية والمادية في حركة توازن مستمرة بحيث لا تطغى طاقة على أخرى. يبحث الإنسان عن سبل العيش، لكنه لا يستسلم لجشع يحول بينه وبين إقامة علاقات إنسانية، أو بينه وبين التضحية من أجل الوطن. يعمل الإنسان على تحسين أوضاعه المادية لكنه لا يحقق ذلك من خلال استغلال الآخرين، وله شهوات من حقه التعبير عنها، لكن ليس بظلم الآخرين أو الاعتداء عليهم، وهكذا. أي أن المناخ التربوي يجب أن يحرص على انبثاق هذه الطاقات ضمن رؤية توازنية فيما بينها بحيث لا تطغى إحداها على أخرى، ولا تتراجع إحداها لحساب أخرى. هذا بحد ذاته هو الإبداع الإنساني لأنه يتطلب حركة مستمرة بين العام والخاص، بين الإنساني والانضباط الشهواني، بين الفردي والجماعي، بين التقدم المادي والتكامل الإنساني، بين محبة الذات ومحبة الآخرين، بين الإنجاز والأخذ بيد الآخرين غير القادرين، الخ. أي أن العملية التربوية لا تقوم على مصلحة خاصة فحسب وإنما على توازن بين المصلحتين الخاصة والعامة، وعلى تفاعل حيوي نشط بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي.
العملية التربوية المنسجمة مع هذه المقطوعة هي تلك التي ترفض استغلال الناس، وتقيم مفاهيم المساواة والعدالة التي تعترف بالحقوق وبالقدرة على الإنجاز في ذات الوقت. يتلقى الأطفال تربية إنسانية تسودها قيم إنسانية متعددة الجوانب يتفاعل بعضها مع بعض تبادليا وتكامليا، وبها يتعلمون احترام الإنسان وتقديره وفتح المجالات أمامه ليعبر عن ذاته، وليشق طريقه نحو الإبداع. كما أن المقطوعة تؤكد من خلال تركيزها على انبثاق الطاقات الإنسانية أن كل أعمال الانحياز القائم على أسس غير إنجازية أو مهنية يشكل عرقلة لانبثاق هذه الطاقات، ويلحق الأضرار بعملية التقدم والبناء.
الخلاصة
إذا استمرت الأوضاع والنشاطات الاقتصادية العالمية على ما هي عليه الآن، فإنه من المستحيل أن يتجنب هذا العالم الصراعات الدموية بين مختلف فئات الناس. السياسات الاقتصادية القائمة حاليا ترفع من مستويات الإنتاج، لكنها تسيء كثيرا إلى العدالة بين الناس وتقلل أعداد الأثرياء جدا، وترفع من أعداد الفقراء المدقعين. هناك الآن مركزة كبيرة لرأس المال، وهناك مئات الملايين من الجوعى وسكان العشش. الصدقة والإحسان لن يحلا المشكلة، وما دامت المشكلة قائمة فإن خطر الصدام الدموي يبقى ماثلا أمامنا، ودون أن يكون بعيدا..
هناك من قال إن الديمقراطية والرأسمالية الليبرالية الحديثة هما نهاية تاريخ الأنظمة السياسية والاقتصدية. التاريخ لا نهاية له، وسيبقى في حالة حراك مستمر إلى يوم الدين، وخاب كل من ظن أن تروس التاريخ ستتوقف عن الدوران. الرأسمالية القائمة حاليا تقتل نفسها، وتقتل معها بلايين الناس الذين لا يعرفون عن الديمقراطية أو عن الرأسمالية. لقد سدت الرأسمالية فراغا تاريخيا من زاوية نشوء النظم الاقتصادية واندثارها، وأراها الآن في حالة صراع كبير مع نفيها. فبدل أن ننتظر الصراع، علينا أن نبادر إلى وضع الحلول، وإن لم نعمل على السيطرة على الأحداث فإن الأحداث ستسيطر علينا.
إذا نظرنا إلى كل الأنظمة السياسية والاقتصادية عبر التاريخ نجد أن العنصر الأخلاقي هو الذي ذهب بها. ازدهرت الحضارات والأمم بأخلاقها، واضمحلت عندما تدنت أخلاقها. أي أن المفتاح الحقيقي لفهم الأوضاع هو المستوى الأخلاقي الذي ينعكس حتما وبقوة على المستوى السياسي. فإذا ارتقى مستوى حساسية النظام السياسي للأخلاق (وليس للخلق فقط) فإن العديد من المشاكل يتم تجنبها.
كإجمال لأفكار رئيسية وردت في هذه المقطوعة في تباين مع الرأسمالية، أذكر التالي:
1- يشكل ثالوث الرأسماليين ووسائل الإعلام والسياسيين الحكام خطرا على العلاقات الإنسانية وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي، وترى المقطوعة ضرورة التخلص منه بعزل السياسي عن الثالوث من خلال انتخابات لا ترتبط بالتمويل الرأسمالي؛
2- تنطلق الرأسمالية من مبدأ الفردية والتحررية، بينما تنطلق هذه المقطوعة من مبدأ أن الإنسان فردي وجماعي في آن واحد؛
3- تقوم الرأسمالية على مبدأ التحررية، بينما ترى الورقة أن الحرية هي الأساس، وهي تتعزز بالتحررية التي لا تتمرد على الطبيعة البشرية؛
4- تتحدد القيم في الرأسمالية تبعا للقيمة العليا وهي القيمة الربحية، بينما ترى هذه الورقة أن القيمة الربحية منبثقة عن قيمة إنسانية أعلى تتعلق بتكامل الطاقات الإنسانية؛
5- الاقتصاد الرأسمالي يمجد النمو الاقتصادي، بينما تمجد الورقة النمو الاقتصادي القائم على حسن التوزيع؛
6- الاستثراء في الرأسمالية مقبول ويعتبر إنجازا، بينما ترى هذه المقطوعة أن الاستثراء عبارة عن آفة يجب منعها؛
7- المقطوعة تركز على إزالة الفقر دون أن تمنع التفاوت في الدخول بين الأفراد، بينما ترى الرأسمالية أن إزالة الفقر عبارة عن نتيجة وليس سياسة متعمدة؛
8- تحدد المقطوعة الملكية الخاصة بينما تفتح الرأسمالية المجال للتمدد في الملكية؛
9- تحرم المقطوعة تجارة المال، بينما تقيم الرأسمالية أسواقا للمال؛
10- الأخلاق بالنسبة للرأسالية نسبية، بينما ترى المقطوعة أن هناك قيما أساسية لا تصلح المجتمعات إلا بها مثل الصدق واحترام العقود والعهود، وأداء الأمانة، واحترام أعراض الناس، والأخذ بيد المحتاجين والضعفاء.
هذا وتشكل المقطوعة رؤية فكرية مختلفة تماما عن الرأسمالية على الرغم من تداخلها معها في بعض المواقع من ناحية التفصيل، ومختلفة عن الاشتراكية على الرغم من تداخلها معها أيضا في بعض التفاصيل وليس في المنطلقات الفكرية. وهي تتداخل من الناحية الفكرية مع الطرح الإسلامي، لكنها تقدم ربطا جدليا بين المستويين السياسي والاقتصادي.
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي