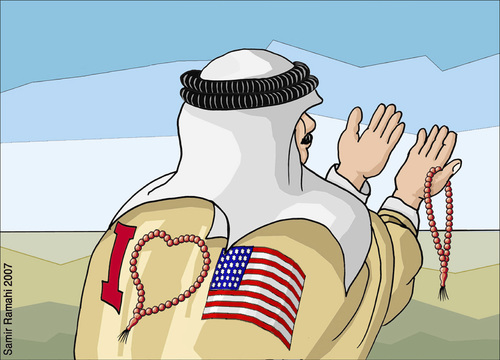عن تعثر الإصلاح في العالم العربي
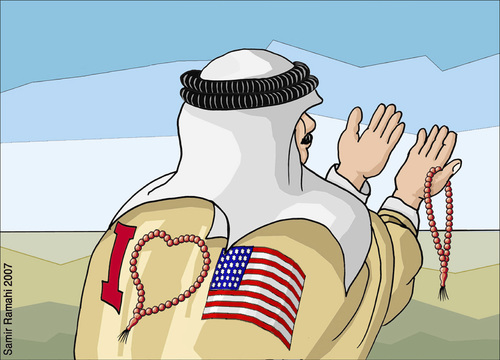
الدكتور عبدالله تركماني
مازالت الأمة العربية تنتقل من إخفاق إلى إخفاق، وعليه، فإنّ القضايا
التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها
مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نتعاطى معها
بشجاعة. ونكتفي، هنا، من هذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في
صيغة أسئلة وتساؤلات: ماذا أعددنا لكي نواجه حقبة محاولة فرض الحل
الصهيوني للقضية الفلسطينية وحقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق،
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخططاً للحاضر والمستقبل ؟ هل تتوافر
شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام
مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد
من الأزمات ؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع الديموقراطية،
وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب
الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع التغيير في
الحقبة الماضية ؟ هل تستطيع الحكومات العربية التي لم تتعاطَ - بعد –
مع متطلبات التغيير والإصلاح بأن تبقى على حالها دون إصلاحات وتغييرات
وتجديد ؟ وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تُحكم بشعارات بينما تُحرم من
الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية ؟
ما أحوجنا إلى القيام بعملية مراجعة شاملة لجوانب حياتنا، ومواجهة
شجاعة مع مشاكلنا، ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات بالشعارات ولا
تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بد من وعي صادق ومكاشفة كاملة
تطفو فيها الحقائق على السطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها،
وتتقدم الشفافية لتنشىء مجتمعاً عربياً ذا
مصداقية
واحترام في عالم اليوم،
يواجه مشكلاته بوضوح ويتعامل معها
بشكل مباشر، وينفتح على الغير، وترتفع فيه قيم الإنسان وكرامته، وتتحدد
معه صلاحيات الحاكم الفرد.
ومن المؤكد أننا لسنا بحاجة لشعارات من أجل التعاطي المجدي مع التحديات
الكبيرة المطروحة على أمتنا العربية، بل الارتقاء إلى مستوى التحديات،
بما يخدم مصالح الأمة ويضمن حقوقها الأساسية في السيادة والحرية
والاستقلال والتقدم.
لعلنا بذلك نفتح من جديد باب التاريخ وندق أبواب المستقبل وننهض لإطلاق
خطاب عربي عصري، عناوينه في توجهاته ومضامينه وفي تجديدنا له، يحتمل
دائماً التأويل والتعديل لصالح شعوبنا العربية. إنها إعادة قراءة
واجبة، ليس فقط في تجديد هذا الخطاب وإنما في تجديد العقل العربي
المدعو إلى خوض مغامرة المستقبل بأدوات جديدة وأفق مفتوح وحوار دائم
على المصالح والأهداف والممكن والمستحيل.
لم تكن الحرب على العراق واحتلاله، كما لم تكن المخاطر المحيطة بالقضية
الفلسطينية بما يصعب معه قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولم يكن
إخفاقنا في التنمية الإنسانية في مجالات الحرية ودور المرأة ومجتمع
المعرفة. لم يكن كل ذلك بداية لأزماتنا ولا نهاية لمصائبنا إنما هو
مرآة مكبّرة لتقاعسنا عن إصلاح أنفسنا، ولعجزنا عن تشكيل أفضل
لمجتمعاتنا، ولتكاسلنا في عملية الذود عن موقعنا في العالم. إنها مرآة
لواقعنا، وصورة عن اللامبالاة بضرورة التغيير، وعن غياب التضامن
العربي الفعلي والمجدي، وعن التلكؤ في دخول العصر.
لقد حان الوقت للتغيير، لبدء الطريق نحو التخلص من التبعية والتهميش
وإعادة إنتاج الفقر والتأخر والتفاوت والجهل والتسلط، وذلك من خلال
الاعتراف بانهيار عصر عربي بأنظمته وأحزابه ومؤتمراته وعقائده، وإجراء
مراجعة شاملة للشعارات الكبيرة المعتمدة على أفكار تجاوزها الزمن، ونقد
للذات، والبدء بقبول وفهم الوقائع العالمية الجديدة وانعكاساتها
المحلية، ووضع حلول للحاضر والمستقبل لا تُستحضر من مفاهيم الماضي إلا
بمقدار ما تنطوي على جدوى للحاضر والمستقبل.
وإذ تلح الحاجة إلى الإصلاح تمعن أغلب الحكومات وبعض النخب في ممانعتها
وترددها، متذرعة برفض إملاءات الخارج والتصدي لمخططاته ومؤامراته،
واضعة نفسها وشعوبها في مأزق لا تستطيع معه التقدم على طريق الإصلاح
ولا التعاطي المجدي مع إملاءات الخارج.
ويبدو أنّ التغيير والإصلاح في العالم العربي لن يرى النور إلا إذا
توفر شرطان أساسيان هما: أولا، أن يتقبل أهل الحكم كل ما قد تسفر عنه
نتائج التغيير والإصلاح، بما في ذلك التضحية بوهج السلطة وبريقها، أو
على الأقل توسيع قاعدة المشاركة السياسية بما يضمن التداول السلمي
للسلطة وفقاً لانتخابات حرة ونزيهة. وثانيا، أن تسعى الشعوب العربية
إلي الضغط باستمرار على الحكام للحيلولة دون الحيدان عن طريق الإصلاح
وأن تعتبره حقاً مكتسباً لا تراجع عنه.
وحتى لا تجرفنا غبطة بيانات الإصلاح بعيداً عن أرض الواقع، تجدر
الإشارة إلى ضرورة إحداث تغييرات حقيقية وليس مجرد ديكورات شكلية، إذ
أنّ الوصاية على شعوبنا والنظر للتغيير باعتباره منة أو هبة يمنحها
الحاكم لرعاياه جعلت من التغيير ضرباً من الخيال، مما يتطلب ضرورة
الانعتاق من هذا النهج السلطوي حتى يصبح للإصلاح معنى وقيمة.
والحق يقال، إنّ أحد أهم أسباب البطء الشديد في تقدم حركة الإصلاح وفي
سوء أداء الحكومات العربية وأحزابها في التعامل مع قوى المعارضة
والتغيير، هو الافتقار للخبرة في العمل السياسي. فالسياسة، بالنسبة إلى
معظم المسؤولين العرب، تعني فرض الطاعة للسلطة من خلال توزيع المناصب
والمنافع الشخصية أو الحرمان منها، أو من خلال القمع والاعتقال. أما
السياسة، بمعنى التوافق والتراضي والتفاوض وإقامة التحالفات وتقديم
التنازلات وتنشئة أجيال جديدة وتدريبها على العمل السياسي تمهيداً
لتولي المسؤولية في المستقبل، فهذه لا يوجد من يتقنها لأنه لا يوجد من
مارسها.
وفي كل الأحوال، لاجدال في كون المطلوب ليس تغيير شخص أو حكومة أو حتى
سياسة، وإنما إصلاح النظام السياسي العربي برمته، حيث لم يعد يختلف
عاقلان في فساده ولا شرعيته وفشله.
إنّ إعادة بناء مفهوم الدولة داخل الفكر السياسي العربي المعاصر،
منظوراً إليها من زاوية كونها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية
وتوازنات القوى فيها، ستسمح بإعادة تمثّل مسألة الديمقراطية والنضال
الديمقراطي، كما ستخرج الأحزاب السياسية من عزلتها وستدفعها إلى الخروج
بالعمل السياسي من دوائره المغلقة إلى الدائرة الجماهيرية الأوسع،
وستنقذ التفكير السياسي من مصطلحات القاموس العسكري، كما ستقلص من
مظاهر ممارسة السياسة بمنطق الحرب.
إنّ الديمقراطية اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه
إليها أو يطالبها به، إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل
الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع
وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن المجتمع من إدارة أوجه
الاختلاف في الآراء وتباين المصالح الاجتماعية بشكل سلمي. وتمكّن
الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن
والحروب الأهلية. وتصل الديمقراطية إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة
الديمقراطية بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في
المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت من ذلك
عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من
حيث الدين والتاريخ والثقافة.
أما في عالمنا العربي فما زالت أغلبية حكوماته تركز على الخصوصية لرفض
الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا.
وكان من نتيجة ذلك: الإحباط، اليأس، الفقر، المديونية، البطالة، أزمة
هوية وانتماء، نزعات طائفية وإثنية، أنظمة وعلاقات عشائرية وقبلية،
أزمة في علاقة المجتمع بالسلطة، وأزمة داخل المجتمع محورها غياب مفهوم
المواطنة، وأزمة داخل الحكومات محورها غياب المشروعية، أزمة مثقفين
وثقافة.
وتكتسب الدعوة إلى الديمقراطية أهميتها مما تشهده بعض أقطارنا العربية
من انقسامات عمودية، تهدد وحدتها وتسهّل لأعداء الأمة تمرير مخططاتهم
التقسيمية على أسس ما قبل وطنية. إنّ إدارة التعددية الفكرية والسياسية
بشكل حضاري، بما تفرضه من قيام مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية
مستقلة، وبما تفرضه من علاقة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات،
تحمل بين طياتها إغناء لوحدة مكوّنات الدولة. ولذا، فإنه ليس من قبيل
الترف الفكري الدعوة إلى ضرورة تطوير نسق ديمقراطي مؤسس على مشروعية
التعددية وحق الاختلاف، مما يتطلب:
1 - وفاقاً بين السلطات القائمة في أقطارنا العربية وبنى المجتمع
المدني لصياغة حل انتقالي تدريجي نحو الديمقراطية، بحيث تتم دمقرطة
هياكل السلطة وبنى المجتمع المدني في آن واحد، ضمن إطار توافق على
مضمونه ومراحله مجموع القوى والتيارات السياسية والفكرية الأساسية.
ويبدو واضحاً أنّ نجاح هذا المسار مرهون بمدى استعداد السلطات العربية
لترشيد بنائها على أسس عقلانية وديمقراطية. ولعل البدء بعدالة
انتقالية، تعالج أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، يكون أحد التعبيرات
عن رشد المجتمعين السياسي والمدني في العالم العربي.
2 - استحضار الخريطة الاجتماعية العربية للتعرف على مدى قدرة المجتمعات
العربية على استيعاب القيم الديمقراطية وفسح المجال أمام مؤسسات
المجتمع المدني، وذلك لأنّ أغلبية النخب السياسية العربية تخشى
الديمقراطية الحقيقية، وتتخوف من نتائجها، بسبب كون علاقاتها بجسم هذه
المجتمعات لا تمر عبر قنوات ومنظمات المجتمع المدني التي تجعل في
الإمكان احترام قواعد الممارسة الديمقراطية.
3 - إنّ الديمقراطية عملية مستمرة، تتضمن معاني التعلم والتدريب
والتراكم، ولذلك فإنّ أفضل طريق لتدعيم الديمقراطية هو ممارسة المزيد
منها. كما أنها ليست عملية قائمة بذاتها، بل لها متطلباتها وشروطها
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية. ولذلك فإنّ
العبرة ليست بتحقيق التحوّل الديمقراطي فحسب، ولكن توفير ضمانات
استمراره وعدم التراجع عنه، وذلك بتجذيره في البنى السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمجتمع. كما أنّ الديمقراطية ليست
نظاماً بلا أخطاء أو بلا مشكلات، بل لها مشكلاتها حتى في الديمقراطيات
العريقة، وهنا تبرز أهمية القدرة على تطوير أساليب وآليات فعالة لتصحيح
مسارات التطور الديمقراطي. وبغض النظر عن المعاني المتعددة لمفهوم
الديمقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية:
توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقاً
للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدد السياسي والفكري.
ومن المؤكد على كل حال، أنّ الوعي بالديموقراطية قد تسرب إلى عدد أكبر
من الناس في عالمنا العربي. ومن المؤكد أيضاً، أنّ أوضاعاً كثيرة لن
تبقى على سابق عهدها.
تونس في
10/11/2010
الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس