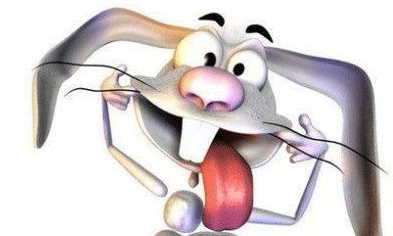ثمة
أفرادٌ، من داخل
أحزاب اليسار
اللبناني وخارجها،
يحاولون أن يعيدوا
لمَّ صفوف اليسار
والعَلمانيين على
ثلاث جبهات. الأولى
هي جبهة إحياء
«التجمّع الوطنيّ
للإنقاذ والتغيير»
(الحزب الشيوعي، حركة
الشعب، التنظيم
الشعبي الناصري،
الحزب الديموقراطي
الشعبي، بعض
القوميّين
الاجتماعيّين ،
مستقلّون،...).
والثانية هي جبهة
إحياء «اللقاء
اليساري التشاوري»
(الحزب الشيوعي
أيضاً، بعضُ قدامى
منظمة العمل الشيوعي،
تروتسكيّون، التجمّع
اليساري من أجل
التغيير،
مستقلّون،...). أما
الجبهة الثالثة فهي
جبهة الأندية
الثقافيّة (نادي
الساحة، نادي اللقاء،
حملة مقاطعة داعمي
إسرائيل، المنتدى
الثقافي،...) التي
أصيبت بنكسة كبرى بعد
اغتيال الحريري ونشوء
الهاجس الأمنيّ من
جرّاء الاغتيالات
الشهيرة.
فأيُّ نصيب لهذه
المساعي الترميميّة
من النجاح؟
***
لنقلْ إنّ معظم
المنضوين في واحد من
هذه الأطر أو أكثر
(وأنا منهم) يستشعر
حاجةً جدّيةً إلى
إحيائها أو إصلاحها.
ولا تنبع هذه الحاجة
من مجرّد الرغبة في
نزع الصدأ عن ماكينات
اليسار، بل تنبع
أيضاً من معاينة «أهل
اليسار» لتزايد
الممتعضين من أداء
المعسكريْن
السائديْن، أو من
انحيازهما الأعمى إلى
الأنظمة السعوديّة أو
السوريّة أو
الإيرانيّة، أو
تجاهلهما أموراً
أساسيّةً من قبيل:
إقرار الزواج المدني
الاختياري، وتعاظم
نفوذ رجال الدين،
وحرمان فلسطينيّي
لبنان من حقوقهم
المدنيّة، وتحاصُص
الوظائف العامّة.
ويسمع اليساريون
انتقادات شعبيّة
متصاعدة لكلا
المعسكرين من نوع:
كيف يَرفع 14 آذار
شعارَ «حُبّ الحياة»
ويَصْمت في الوقت
نفسه عن ثقافة الموت
الوهّابيّة؟ وكيف
يقاتل حزبُ الله
الصهيونيّةَ
والاستعمارَ وينعى في
الوقت ذاته عبد
العزيز الحكيم الذي
قدِم إلى العراق على
ظهر الدبّابات
الأميركيّة؟ وكيف
خَوّن كلٌّ من
المعسكريْن الآخرَ
طوال سنوات، ثم عادا
إلى الجلوس معاً
بذريعة أنّ «لبنان
هيك»؟ وكيف تحوّل
ميشال عون «العلماني»
عام 2005 إلى زعيم لا
يكلّ ولا يملّ اليومَ
من التبجّح بتمثيله
المسيحيّ الأوسع؟
وكيف...؟
***
ووسط خيبات أهل
اليسار من
المعسكريْن، ودنوِّ
انسحاب البيك
الاشتراكي من 14 آذار
مخلّفاً إيّاه بلا
«يسار» (باستثناء
يسار الديكور)، تنْشط
منذ بضع سنوات عشرات
المنظّمات غير
الحكوميّة، فتستقطب
مئات اليساريين
المتعلّمين، ولا
سيّما من المتخرّجين
الجدد، وتقدِّم إليهم
وظائف مجْزية، وتوظّف
كفاءاتهم الأكاديميّة
والفنّيّة في مجالات
متنوّعة (إصلاح
السياسة البيئيّة،
مراقبة الانتخابات
النيابيّة،...). غير
أنّ العقليّة
الليبراليّة
المؤنْجَزَة [من أن.
جي. أوز أي المنظمات
الدولية غير
الحكومية] لم تلبِّ
هي الأخرى من خلال
منظماتها الدولية غير
الحكومية، مطامح كثير
من أولئك الشباب
الذين سرعان ما
أدركوا انخفاض سقفها
السياسي، أو شهدوا
فساد بعض طواقمها
الإداريّة
ولاشفافيّتها، أو
لاحظوا عدم وفائها
بما كانت قد وعدتْ به
من «كشف للأشياء
بأسمائها» (انظرْ،
على سبيل المثال،
مقال ريتا باروتا
الساخر في جريدة «الأخبار»
في 25/8/2009).
بعض اليساريين بقي في
تلك المنظّمات على
مضض، مبرِّراً ذلك
بأنّ أحزاب اليسار ما
زالت تَستخدم
الآليّات التقليديّة
التي عفّى عليها
الزمنُ؛ بل قد يذهب
إلى أنها أفلستْ،
وأنّ شيئاً لن يبعثها
من رمادها. وبعضُهم
أقرّ على استحياء
بأنّ أحزابَه السابقة
لم تقدّمْ له أيَّ
دخل، على الرغم من
تفانيه في خدمتها
طوال سنوات، ولذلك لم
يعد في مقدوره
الاستمرار فيها. لكنّ
يساريين «مؤنجَزين»
آخرين ما زالوا
يمنّون النفسَ بأن
ينتعش اليسار من
جديد، فيعودوا إلى
الانخراط فيه (من دون
التخلّي عن وظائفهم
الحاليّة المجْزية
طبعاً)، سعياً وراء
أهداف باتوا يدركون،
بعمق، أنّ منظمات
الأنجزة أعجزُ من
تبنّيها بسبب
ارتباطها التمويليّ
بالغرب.
***
علاوةً على ذلك،
يدرك اليساريون
اللبنانيون اليوم،
بجميع أطيافهم، أنهم
«بالهوا سوا»، وأنّ
القارب يَغرق بهم
مهما كانت
إيديولوجيّاتُهم،
وأنّ إصرارَهم على
المماحكات لم يعد
يُجدي فتيلاً،
فتدفعهم غريزةُ
البقاء إلى التنادي
والإمساك بخشبة إنقاذ
ما... أو ربما ظنّوا
أنّ «تَسانُدَ
أنقاضهم» سيَحول دون
اندثارهم النهائي.
كذلك تدرك الأنديةُ
الثقافيّةُ اليساريّة
أنْ لا سبيل إلى فتح
ثغرة في جدار الثقافة
السائدة ـــــ وهي في
غالبها ثقافةٌ
«ليبراليّةٌ» تعمل في
خدمة رأسماليّة
الطوائف ودول النفط
ـــــ إلاّ بشيء من
التنسيق في ما بينها،
ولا سيّما أنّ كلّ
ناد، منفرداً، لا
يَملك إلاّ قجّةً
شحيحةً... ومثقوبة.
***
في كلّ الأحوال، فإنّ الرغبات وحدها، بل الوعي الصحيح بمفرده، لن يكفيا لإخراج اليسار وأنديته الثقافيّة من مأزقه. لذا أقترح هنا بعض الأفكار التي أعتقد أنها قد تكون مفيدة للبدء في ورشة الإعمار اليساري في لبنان، منوّهاً بأنّ اقتراحاتي ليست على سبيل «التمريك» أو «الأستذة»: فأنا من هذا اليسار، وأفْخر ـــــ بالرغم من كلّ انتقاداتي المكتوبة والشفويّة ـــــ بأنني أحدُ مؤسّسي «حركة الشعب» و«التجمّع الوطني للإنقاذ والتغيير» و«التجمّع الوطني العلماني» و«نادي الساحة» و«حملة مقاطعي داعمي إسرائيل» و«تجمّع الأندية الثقافيّة». لذا فإنّ ملاحظاتي هنا هي من باب النقد من الداخل، بل قد تكون من باب نقد الذات أيضاً.
***
أولاً،
ضرورة تخصيص الجلسات
العتيدة الأولى، سواء
في «التجمّع الوطني
للإنقاذ والتغيير» أو
«التجمّع الوطني
العَلماني» أو
«اللقاء اليساري
التشاوري» أو «لقاء
الأندية الثقافيّة»،
للقيام بنقد موضوعيٍّ
وذاتيٍّ صارم لتجربة
العمل المشترك في
السنوات الماضية. ولا
أقصد بالنقد الذاتي
ذاك الذي يقوم به
معظمُ «المسؤولين»
أملاً في إظهار فضيلة
موهومة، ونكران ذات
متخيَّل. ولا أقصد
به، يقيناً، نقداً
على الطراز الوليد
جنبلاطيّ، حيث
«ينتقد» المرءُ ذاتَه
لكنّه يبقى في منصبه
بدلاً من أن يعلنَ
ـــــ من تلقاء نفسه
ـــــ امتناعَه مثلاً
عن الترشّح إلى أيّ
منصب قيادي ولو فترة
معيّنة من الزمن،
فاسحاً المجالَ أمام
عناصر أخرى لتتولّى
زمام الأمور.
ولا يكفي أن تكون هذه
العناصرُ شابّةً
بالمناسبة، لأنّ بعضَ
الشباب (على ما
لاحظتُ في تجربتي
السياسيّة في العقد
الأخير خاصّة) قد
يكون أقلَّ حيويّةً
ومبادرةً وسَعَةَ
خيالٍ من «الشيوخ»،
وبخاصّة حين يكون
الشاب «شبابويّاً»،
أيْ يبالغ في تقدير
أفكاره استناداً إلى
عمره وحده. كما أنّ
التمثيل «النسائي»
ليس كفيلاً في ذاته
بتحسين القيادات (مع
أنني لستُ ضدّ مبدأ
الكوطا النسائيّة)،
لأنّ بعضَ النساء
أكثرُ تحجّراً
وتخويناً من كثير من
الرجال.
وبالمناسبة أيضاً،
أليس غريباً أنّ
الغالبيّة العظمى من
قادة «الحركة
الوطنيّة اللبنانيّة»
لم يُجْروا أيّ نوع
عميق من النقد
الذاتي؟ وها قد
حَملتْ أحزابُنا هذا
الإرثَ، بحسناته
وسيّئاته، ورحنا
نؤسِّس معها تجمّعاً
تلو تجمّع، ولقاءً
إثر لقاء، من دون أن
نبيّنَ لأنصارنا
ولأنفسنا لماذا فشلتْ
تجاربُنا السابقة،
وضمنها التجربة
المؤسِّسة الكبرى، أي
الحركة الوطنيّة.
ومع ذلك، فقد أسعدني
أن يقوم الرفيق سعد
الله مزرعاني
بالتلميح إلى
مسؤوليّة ما لحزبه
(الحزب الشيوعيّ
اللبنانيّ) في تعثّر
عمل «التجمّع الوطني
للإنقاذ والتغيير» (الأخبار،
29/8/2009)، وإنْ
كنتُ آملُ أن يحدّدَ
العواملَ الداخليّةَ
المسؤولةَ عن انسحاب
الحزب، وعن أسباب عدم
عودة الحزب المذكور
إلى إطار «التجمّع»
بعد إقراره بخطأ
الانسحاب. وبالمثل،
فإننا ننتظر من حركة
الشعب، وهي الأحرصُ
على «التجمّع» في
رأيي، أن تبيّنَ
مسؤوليّتَها عن بعض
عثراته، وأن تبادرَ
إلى إعادة إحيائه،
متجاوزةً سلبيّاته
السابقة، التي هي
أقدرُ من أيٍّ كان
على تحديدها.
وإذا كان لي، من باب
النقد الذاتي، أن
أقدّمَ إشارات
متواضعة إلى
مسؤوليّتي الشخصيّة
عن الشلل (المؤقّت
كما آمل) الذي أصاب
حملة مقاطعة داعمي
إسرائيل (2002 ـــــ
2007) ونادي الساحة
(1999 ـــــ 2006)،
فسأوجزُها بما يأتي:
عجْز العاملين
الأساسيين فيهما
(وأنا منهم كما سبق
الذكْر) عن الإسهام
في تحويلهما إلى
مؤسّستيْن قائمتيْن
بذاتهما، بحيث غَلَبَ
في النهاية طابَعُ
المكتسَبات والمهارات
الفرديّة (القراءات
الشخصيّة، العلاقات
بمثقفي الخارج،...)
لدى حفنة من أعضائهما
على بناء قاعدة
إداريّة حقيقيّة
تُديم عملَهما. وأضيف
إلى ذلك صرْفي،
وآخرين، وقتاً أطولَ
ممّا ينبغي، وبخاصة
في مراحل التأسيس،
لتكريس استقلاليّة
حملة المقاطعة ونادي
الساحة عن حركة
الشعب، الأمرُ الذي
نفّر بعضَ أعضاء
«الحركة». وعلاوةً
على ذلك، فقد أمضيتُ،
وبعضَ الرفاق، وقتاً
أكثرَ ممّا ينبغي على
الأرجح في «مناقرة»
أصحاب مقولة «مقاطعة
كلّ الشركات
الأميركيّة» بدلاً من
«الشركات الداعمة
لإسرائيل مهما كانت
جنسيّتُها». ولعلّي
أضيف أخيراً أنّ
النادي غلّب القضيّةَ
القوميّةَ
(الفلسطينيّة بوجه
خاصّ) على القضايا
المحلّيّة (العلمنة،
الزواج المدني،
المسألة
الاقتصاديّة،...)،
فأسهم ذلك ـــــ عن
غير قصد منّا ـــــ
في إضعاف جاذبيّته
لدى الشباب اللبناني.
ولكنْ يبقى أنّ
أسبابَ تعثّر الحملة
والنادي أعظمُ من
مسؤوليّتي الشخصيّة
بالتأكيد؛ فلا
الإمكانيّات الماليّة
كانت موجودةً ولو في
حدودها الدنيا، ولا
متفرّغون على
الإطلاق، فضلاً عن
أنّ الجوّ الذي أعقب
اغتيالَ الحريري ساعد
في تدهور اهتمام
الشباب بالثقافة
وبمقاومة الصهيونيّة
اقتصاديّاً (عبر
مقاطعة الشركات التي
تدعمها) لحساب الهاجس
الأمنيّ وإدانة
النظام السوري.
على أنني أسارع إلى
القول، منعاً لأيّ
سوء فهم، إنني لا
أتنكّر لخياراتي
آنذاك. فإيماني
باستقلاليّة العمل
الثقافي عن العمل
الحزبي والسياسي
المباشر يبقى راسخاً
(من يذْكر كيف
حَطّمتْ أحزابُ
الحركة الوطنيّة،
بتحاصصاتها السخيفة
ورغبتها المقيتة في
الهيمنة، تجربةً
لبنانيّةً فريدةً في
الوطن العربي، هي
اتحادُ الكتّاب
اللبنانيين؟).
أمّا إصراري، مع بعض
رفاقي في حملة
المقاطعة، على تغليب
العداء للصهيونيّة
على العداء
لـ«أميركا»، فقد كانت
له آنذاك، ولا تزال
له الآن، مبرّراتُه:
فنحن لم نُرِدْ
يومَها، ولا إخال
أننا نريد اليوم، أن
نقاطعَ الشركات
الأميركيّة من دون أن
نقاطعَ شركات غير
أميركيّة تدعم
إسرائيل مباشرة
(كشركة نسله
السويسريّة)؛ ولذا
ركّزنا على شركات
بعينها، من مختلف
الجنسيّات، ومن
مجالات متنوّعة
(أغذية، آلات بناء،
مستحضرات تجميل،...)،
حرصاً على نجاح
الحملة وإمكانيّة
تجاوب الجمهور العريض
معها. ولا أُخفي أنّ
أحدَ الأسباب التي
دفعتنا ـــــ عن خطأ
أو صواب ـــــ إلى
عدم حصر المقاطعة
بأميركا قد كان
خشيتنا، كعلمانيين،
من أن ترتدّ علينا
هذه المقاطعة الأخيرة
دعماً لنزعات سائدة
في بعض قطاعات من
مجتمعنا، عنيتُ:
كراهية أميركا ككلّ،
أيْ من دون تمييز بين
مجتمع وثقافة وقيادة
حاكمة.
***
ثانياً،
ضرورة بناء جسم ثقافي
فعّال داخل كلّ حزب
أو حركة سياسيّة،
وداخل الأطر
اليساريّة المشتركة
كذلك. ولقد سبق أن
ذكرتُ، في غير مقال،
أنّ هياكلنا
اليساريّة بالغةُ
الهشاشة ثقافيّاً:
فرُبَّ شابٍّ شيوعي
لبناني لم يقرأ من
«الشيوعيّة» إلا
بيانات الأمين العامّ
لحزبه؛ ورُبّ كهل
قومي عربي لم يقرأ
كلمة للحصري أو عبد
الناصر أو عفلق...؛
ورُبّ شابّة يساريّة
«جديدة» لم تسمعْ
بياسين الحافظ أو
إلياس مرقص أو لم
تقرأْ شيئًا لحسين
مروّة أو مهدي
عامل... هذا ناهيكم
بأنّ بعضَ شبابنا
اليساري يخْلط بين
«العلمنة»
و«العولمة»، أو
يتشدّق بمصطلحات
«المواطَنة»
و«التمكين» و«المجتمع
المدنيّ»
و«الاستشراق» من دون
أن يفقهَ سياقاتها
التاريخيّة في كثير
من الأحيان.
وعلينا الإقرارُ،
هنا، بأنّ هذا
الإدقاعَ الثقافي في
صفوف اليساريعود إلى
سببيْن رئيسيْن هما:
1 ـــــ عدمُ اقتناع
بعض القادة
اليساريّين بأهميّة
نشر الثقافة، بل
عدُّهم إيّاها محضَ
ترفٍ لا تَسمحُ به
ظروفُ «المعركة
الضروس التي نخوضها».
2 ـــــ أنّ الثقافة،
في حدّ ذاتها، لم تعد
رأسمالاً رمزيّاً
يمْكن التباهي به في
خضمّ نمط العيش
الاستهلاكي، والتشاوف
بالمقتنيات
المادّيّة، وانزلاق
أقسام كبيرة من
المثقفين العرب إلى
خدمة الطوائف ورأس
المال، وتراجُع إغواء
الأفكار التحرّريّة
الكبرى، وصعوبات
الحياة اليوميّة. غير
أنّ الثقافة، كما لا
ينبغي أن يَخفى،
عاملٌ أساسٌ في
الحفاظ على تماسُك
اليسار، وفي مقاومة
الخصوم السياسيّين،
بل في تطوير أداء
الأحزاب والتجمّعات،
وإقناع المتردّدين
بأهمّيّة العمل في
الحقل العام. ولا
أقصد بـ«الثقافة»
العقائد الكبرى
وحدها، بل أقصدُ
أيضاً الروايات
ودواوين الشعر
والمسرحيّات والسينما
والفلسفات من أيّ
مشرب كانت.
فمتى نَحْزم أمرَنا
كيساريين، ونُولي
الثقافة داخل أحزابنا
وتجمّعاتنا المشتركة
ما تستحقّه؟
***
ثالثاً، وهو مرتبطٌ بما سبقه، ضرورةُ القيام بما سأسمّيه «مثاقفةً يساريّة». وأعني بها التلاقحَ الفكري بين التيّارات اليساريّة في لبنان (وقد ينطبق ذلك على كلّ بلد عربي أيضاً)، بحيث يدعو الناصري الماركسيين إلى ندوة في ناديه، ويدعو الماركسي الناصريين إلى مخيّمه الشبابي، وهكذا. ولعلّ «اللقاءَ اليساري التشاوري» أن يكون أفضلَ مَن يتنكّب هذه المهمّةَ الجليلة؛ بيْد أنّ لقطاعات الشباب، وللأندية الثقافيّة ذاتِ الهوى اليساري، دوراً لا يُستهان به هي أيضاً في هذا المجال. وليس ثمة ما يَمنع أن تتّسعَ «المثاقفةُ اليساريّة» لتشملَ موضوعات كالإصلاح الديني ولاهوت التحرير، ولتنفتحَ على مجموعات ناشطة غير يساريّة (بالمعنى المألوف للكلمة) كـ«الحركة الاجتماعيّة» على سبيل المثال لا الحصر.
***
رابعاً، لزوم أن تضطلع القيادات «الوسيطة»، بدلاً من «العليا» أو «التاريخيّة»، بمهمات التنسيق بين التيّارات اليساريّة المختلفة. فالحالُ أنّ الحزازات الشخصيّة بين القيادات الوسيطة، بحسب ما شهدتُ، أقلُّ من الحزازات بين القيادات التاريخيّة العليا لليسار اللبناني (وربما العربي كذلك). كما أنّ القيادات الوسيطة أكثر قدرةً، في رأيي، على التعاطي بالأمور السياسيّة اليوميّة، وأكثر قدرةً على تذليل الخلافات الثنائيّة. وأرجو ألاّ يُعتبر اقتراحي هذا تدخّلاً في عمل الأحزاب، أو إملاءً لمن يجب أن يكونَ ممثّلها في التجمّعات اليساريّة المختلفة.
***
خامساً، ضرورة إنشاء صندوق يساري موحَّد، مكوّن من اشتراكات الأحزاب المنضوية في التجمّع الوطني للإنقاذ والتغيير (أو اللقاء اليساري التشاوري أو...)، فضلاً عن أرباح حفلات ومهرجانات لفنّانين وطنيين ويساريين، أو نشاطات أخرى أكثر ثباتاً وإنتاجيّةً على غير مستوى. فالحال أنْ لا شيء يمكن تنفيذه بلا مال، لكنّ جهة التمويل ينبغي أن تكون ذاتيّةً (تبعاً للمثل العامّي «مِن دِهنو سَقّيلو») كي يَحْفظَ العملُ اليساري صدقيّته في عيون الناس. ثم إنّ هذا الصندوقَ المقترحَ قد يُسْهم في استعادة بعض كفاءاتنا «المؤجَّرة» اليومَ إلى المنظّمات غير الحكوميّة، وفي الاستفادة منها في أطرها اليساريّة الأولى.
***
وبعدُ، فقد كانت تلك اقتراحات أعْرضها هنا لمعرفتي بأننا على أبواب تحرّكات وطنيّة يساريّة مشتركة مقبلة. أما ما يتداوله البعضُ من إحياء للحركة الوطنيّة اللبنانيّة من دون نقدها، وبزعامة مرتدٍّ عن الارتداد، فلا أراه صواباً!
* رئيس تحرير مجلة الآداب.